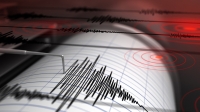ذيبان.. الأزمة في مكان آخر

جو 24 :
كتب د. فيصل الغويين -
فضّ اعتصام شباب ذيبان المطالبين بحقهم الدستوري في العمل وبطريقة أعادتنا عقوداً لمرحلة الأحكام العرفية، يعيدنا من جديد إلى طرح الأسئلة عن المسؤول عما وصلنا إليه وطنياً من مشكلات وتحديات وطنية غير مسبوقة في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحنا معها نستسهل الحلول الأمنية التي ستعمًق الأزمات وتراكم الاحتقانات، بدل البحث الجاد والمسؤول عن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة، والتي لا يمكن فهمهما بدون ممارسة النقد النظري والعملي للنهج السياسي والاقتصادي الذي حكم السياسات العامة ووجهها على مدى ربع قرن على الأقل.
لقد كان حرياً بالنخب السياسية والاقتصادية المتنفذة أن تدرك عمق التحولات الإقليمية والداخلية، وأن تبحث عن رؤية مختلفة لإعادة بناء الأردن والنهوض به، لكن هذه الطبقة ذات الثقافة الرأسمالية الغربية الهجينة لم تكن مؤهلة، أو قادرة، أو راغبة على تغيير جلدها ودورها، بل أسهمت ولا تزال في إجهاض قوى التغيير السياسي والاجتماعي، حفاظاً على مصالحها وارتباطاتها، وساهمت في تدمير بنية الاقتصاد الوطني الإنتاجي من خلال بيوعات مشبوهة لمعظم أصول الدولة والاقتصاد الوطني، الأمر الذي وسّع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية وأخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، وزاد من مركزة الثروة والسلطة في يد أقلية معولمة، حتى أصبح الأردن هامشاً لجزء صغير من عمان.
وساهمت السياسات الليبرالية الجديدة التي انتهجتها الحكومات المتتالية في هيمنة قطاع المال على كافة قطاعات الإقتصاد؛ من خلال تقوية البنوك، وتنمية رؤوس أموالها بأي ثمن، وأبقت سقف الاستدانة العامة مفتوحاً، فتضاعف الإنفاق العام الجاري وغير المنتج، بالتزامن مع إضعاف مؤسسات الرقابة والمحاسبة (مجلس النواب، ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد..)، كما تضاعف الهدر في إنفاق المال العام، وتصاعدت معدلات الفساد والإثراء السريع لأصحاب السلطة والنفوذ، ليتصاعد طردياً تراكم الدين العام وكلفته، وتم دفع الاقتصاد الوطني إلى فخ المديونية، في نفس الوقت الذي تقلصت فيه رؤوس الأموال الموظفة في القطاعات الإنتاجية، (الزراعة والصناعة).
وتشكل الاستدانة لتمويل الإنفاق العام الجاري وغير المنتج سطواً على إنتاج الأجيال المقبلة التي سيكون عليها تحمّل خدمة هذه الديون، إضافة إلى الديون الشخصية التي تثقل كاهن أغلبية المواطنين. وكل ذلك وسّع الهوة بين فئة ثرية مالكة، وأكثرية مدينة فقيرة، الأمر الذي كان وسيكون له انعكاساً على أمن المجتمع والدولة، فزاد التذمر، وانعدمت الثقة بالسياسات العامة، وتزايدت معدلات الفقر والبطالة، وارتفعت نسبة الجريمة، وزاد الإحتقان الاجتماعي، وساد نمط الخلاص الفردي بدلاً من الحلول المجتمعية.
وفاقم من حدة الأزمة تطبيق الحكومات المتتالية لسياسات ليبرالية غير وطنية، كان من ثمارها المرة انسحاب القطاع العام من الكثير من مهماته الاقتصادية والاجتماعية، فتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية، واختفت الرقابة على الأسواق والأسعار، وضعفت كفاءة القطاع العام ومؤسساته، فزاد الفساد الإداري، وزاد الترهل والعجز عن تقديم الخدمة اللائقة للمواطن، مما ضاعف الشعور باليأس والإحباط.
كانت مهمة القطاع العام - قبل اجتياح أيديولوجيا الليبرالية الجديدة - إنتاج الكثير من السلع والخدمات الأساسية التي لها علاقة قوية بالأمن الوطني، ولها أبعاد إستراتيجية، أو لكونها حاجات أساسية وضرورية للمجتمع يصعب الاستغناء عنها، ومن حق المواطن الحصول عليها بأقل كلفة ممكنة.
ومع وصول أفكار ومبادئ الليبرالية الجديد، اختلت القيم والسياسات والمبادئ المعلنة؛ فلم يعد الإنسان هو الغاية من وراء الإنتاج من قبل السياسات العامة، بل أصبح تراكم الربح والثروة هو الغاية، وتحول الإنسان العامل والمنتج إلى وسيلة لتحقيقي تراكم رؤوس الأموال، وأصبحت عوامل السوق من عرض وطلب هي من تحدد قيمته، ومن لا عمل له ولا حاجة إليه في السوق لا قيمة له، وفي أحسن الأوضاع يغدو محط اهتمام الجمعيات الخيرية، وليس مؤسسات الدولة والقطاع العام، فالفقير هو المسؤول عن فقره، وعلى المجتمع التخلي عنه.
وقد جرت التغطية على بؤس هذه السياسات بالتبشير المبرمج بعجز القطاع العام، وارتفاع كفاءة القطاع الخاص، وتردد مصطلح (ترشيق الدولة)، كغطاء لإفشال المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، والعمل على خصخصتها، والاستيلاء عليها بأبخس الأثمان، وتحويلها إلى احتكارات تعيد تقسيم الناتج الوطني لمصلحتها، متخطية كل أشكال الاعتراضات والاحتجاجات على هذا النهج الذي هدر المال العام، وعلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة للأكثرية الساحقة من أبناء الوطن، وأصبحت السياسات المالية للدولة خارج إطار المراجعة والتدقيق والمحاسبة، والمال السائب يعلّم الناس الحرام.
ومع تضخّم المدن وهجرة أبناء الأرياف والبوادي، تراجع وزن الأرياف والبوادي الاقتصادي والسياسي، وأصبح الجميع مرتهن لطبقة الواحد في المئة المتنفذة سياسياً واقتصادياً، وهي طبقة لا تؤمن بالديمقراطية بمفهومها الاجتماعي ولا تمارسها، ولا تؤمن بالإصلاح الحقيقي، ولا تسمح به.
وفي ضوء ما سبق فإنّ الحاجة تبدو ملحّة لإعادة رسم خريطة طريق وطنيّة تستند إلى ما يلي:
1-إعادة النظر جذرياً واستراتيجياً بالنهج السائد اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً؛ للخروج إلى الحرية الحقيقية التي لا تتحقق إلا بإطلاق التنمية الوطنية الشاملة المستندة إلى عقول وسواعد وطنية، تلحظ الميزات النسبية لمناطق المملكة المختلفة، وتستثمرها بعيداً عن الوصفات المستوردة التي عمّقت الفقر، والحرمان، والبطالة، والشعور بالظلم، والتبعية بأبعادها المختلفة. وهذا يعني ضرورة بناء أداة التغيير عبر أوسع تحالف وطني من كل الشرائح برؤية واحدة للواقع، ولعلّ الانتخابات النيابية القادمة تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
2-إن إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي تركز على أسس الحكم الصالح والرشيد تقدم أحسن الفرص لتنمية إنسانية مستدامة، ومن ثم فإن الإخفاق التنموي يتولد من صعود الدور الأمني وتراجع التنمية في سلم أولوياتها إلى ما دون الأجندة الأمنية، مع الافتقار إلى رؤية إستراتيجية تنموية، بما في ذلك إجهاض القطاعات الإنتاجية، وإشاعة الثقافة الاستهلاكية، وإفساح المجال أمام الفساد، والعلاقة العضوية بين النخب السياسية ونخب الثروة، ليعود هذا الإخفاق التنموي فيؤدي إلى خلل في الأمن المجتمعي من خلال الفقر، والبطالة، والتهميش؛ فينتشر العنف، وتعلو التيارات المتطرّفة.
3-وهذا يعني وجود علاقة تبادلية بين التنمية والأمن؛ بحيث يرتبط التقدم في إحداهما بالتقدم في الآخر، والعكس صحيح؛ فالإخفاق التنموي يحدث بالضرورة خللاً أمنياً، وهذا بدوره يقود إلى العنف فيتعزز هذا الإخفاق. ومن هنا تبدو الحاجة إلى الديمقراطية. ويظهر الإرتباط القوي بين التنمية والأمن المجتمعي في مجالات إنفاذ حكم القانون، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وآليات حل الصراعات الاجتماعية دون عنف، وإقرار درجة كافية من الاستقرار السياسي تتيح للأفراد العمل التنموي.
4-تجديد النخب السياسية، وإصلاح أجهزة الدولة، وإعادة الاعتبار لدورها، وإعادة توزيع السلطة السياسية في المجتمع بما ينقل سلطة رسم القرارات وتطبيقها إلى الفئات صاحبة المصلحة، وبما يقيم نظاماً يسمح بالمساءلة والمحاسبة والمشاركة.
5-إعادة تقييم وتقويم منظومة الحكم المحلي التي يتضح عجزها - كجزء من مظاهر العجز العام في منظومة الإدارة العامة-، بحيث تصبح الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والألوية والأقضة، مراكز قيادة للتنمية المحلية، ومغادرة أساليب عفى عليها الزمن في التعامل مع التحديات الاجتماعية، وذلك من خلال إدامة التواصل والحوار المنتج وإدارة المجتمع بطريقة حضارية، حيث لا يزال الإرث العثماني، والعقلية البوليسية هي السائدة في كثير من الحالات.
6-التوزيع الأكثر عدلاً لفرص التنمية والثروة والسلطة، كمدخل لإعادة بناء وتجديد أجهزة الدولة ومؤسساتها التي شاخت، وترهلت، وضعفت إنتاجيتها، وذلك بأن تأخذ القيادات الشابة الكفؤة والمؤهلة، والتي تحظى بالمصداقية العامة، المخلصة لوطنها وشعبها ونظامها، دورها في بناء وطنها، وخدمة شعبها.