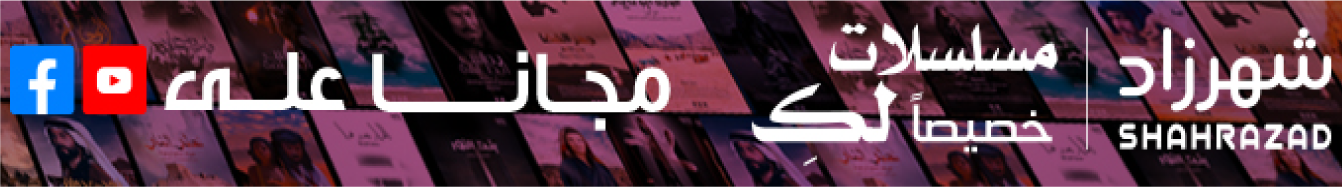سكجها يكتب: وفاء وبيعة، وحيدر محمود و“نشيد الصعاليك”!

استغربت، في يوم، اعتراف محمود درويش أمامي، وبحضور أصدقاء، بقوله: حيدر محمود شاعر كبير، وأقرأ واستمع له بذائقة لا يعرفها سوى الشعراء. كان سبب استغرابي أنّ درويش "شاعر الثورة الفلسطينية”، وحيدر "شاعر القبيلة الأردنية”، وفي مطلق الأحوال، فالاثنان صديقان لي، واحد منهم رحل، وأطال الله في عمر الثاني.
شِعر حيدر محمود ما زال هو الشُعر الذي يُلقى ويُغنّى عن الأردن، منذ نصف قرن، والأغاني التي حيكت على كلماته الحنونة، وغنّاها كبار الكبار، من فيروز إلى نجاة إلى سلوى إلى وإلى وإلى، ما زالت هي التي تتقدّم وتُمّهد لنشرة أخبار الثامنة التاريخية، و”يعشقون الورد لكن… يعشقون الأرض أكثر” جملة عبقرية تُعبّر عن حقيقة الأردنيين، وتجربتهم الحياتية، ولكنّ لحيدر رسالاته الشعرية التاريخية التي سُجّلت علامة في معارضة الواقع القاسي.
في مثل يوم أمس، قبل عشرين سنة، كان المطر ينهمر على الأردن بشكلّ مفاجئ، ويُباغت عمّان التي ستودّع حبيبها الحسين ظُهراً، لتستقبل إبنه عبد الله الذي اختاره قبل قليل ملكاً يُجدّد، ويعيد تعبيد الطريق، فلاحت في ذهني جُملة كتبتها في مقالتي في اليوم التالي: هو مطر حزن، دموعاً تبكي، وهو مطر يُبشّر بالخير الآتي بإذن الله.
حيدر محمود سُمّي "شاعر القبيلة”، وفي ليلة بوح معه وثالثنا سمير عربيات، صارحته بذلك الوصف، فبدا سعيداً، وردّ بكلّ بساطة وعفوية:”أنا فخور بذلك، فالأردن قبيلة، وإذا كنتُ أنا شاعرها فعلاً، فذلك آخر المُنى”، وأضاف:”أنا الذي وُلدت على موجة بحر حيفاوية، وصرت أردنياً مع قهر هجرة، أتشرّف بكوني شاعر قبيلتي”.
تُرى، هل أكتب هنا عن حيدر، أم عن الحسين الذي أدمعت عيناه مع كلامه أمامه، وعمّا قاله عن أهل وآل البيت، أم إكتب عن الإبن الذي عانقته كلمات حيدر: مع عبدالله يداً بيد؟ أم لعلّني أكتب عن سنوات كانت تحتلّها الصعوب، ويستأهل معها أن تكون يدنا بيده؟
أكتب، باختصار، اليوم عن كلّ ذلك: عن شاعر القبيلة الأردنية حيدر، وعن الحسين الذي أمطرت السماءُ دموعاً مدرارة حُزناً عليه، وعن الغيوم التي جادت بكرمها بُشارة خير بعبده، وعن الأردن الجديد المتجدّد، الذي أراد سيّده اليوم أن يكون الاحتفال بذكرى رحيل أبيه، أكثر بكثير ممّا يُحتفى بالإبن، وهو يستأهل احتفالات سنة كاملة، حيث عشرون سنة من الوفاء للانجاز.
الملك عبد الله الثاني بن الحسين قدّم اليوم في كلمة قصيرة، ما يمكن أن يختصر عُمراً كاملاً من الدولة الأردنية: "الإنسان أغلى ما نملك”، ولعلّ رسالة الملك الأب والإبن، تصل إلى عنوانها، فيكون الشعار هو الواقع الحقيقي على الأرض، وبالطبع، فنحن نقصد الحكومات.
وأعود إلى حيدر محمود، باعتباره "شاعر القبيلة الأردنية” بامتياز، فأسأله: تُرى هل غاب عنك وحي الشِعر وبوح الكلمات، في يوم حميم، أم أنّك تكتب الآن ما يشبه "نشيد الصعاليك”، التي كانت رسالة بليغة للحسين، وكان لها ما بعدها، وما بعدها، وما بعدها، وللحديث بقية!
وأنشر، هنا، نص قصيدة :”نشيد الصعاليك”، لحبيبنا حيدر محمود:
عفا الصّفا.. وانتفى.. يا مصطفى.. وعلتْ ظهورَ خير المطايا.. شرُّ فرسانِ
فلا تَلُمْ شعبك المقهورَ، إنْ وقعتْ عيناكَ فيه، على مليون سكرانِ!
قد حَكّموا فيه أَفّاقينَ.. ما وقفوا يوماً بإربدَ أو طافوا بشيحانِ
ولا بوادي الشّتا ناموا.. ولا شربوا من ماءِ راحوبَ.. أو هاموا بحسبان!
فأمعنوا فيه تشليحاً.. وبهدلةً ولم يقلْ أَحدٌ كاني.. ولا ماني!
ومن يقولُ؟.. وكلُّ الناطقين مَضَوْا ولم يَعُدْ في بلادي.. غيرُ خُرسانِ!
ومَنْ نُعاتبُ؟.. والسكيّنُ مِنْ دَمِنا ومن نحاسِبُ؟.. والقاضي هو الجاني!
يا شاعرَ الشَّعبِ.. صارَ الشّعبُ.. مزرعةً، لحفنةٍ من عكاريتٍ.. وزُعرانِ!
لا يخجلونَ.. وقد باعوا شواربَنا.. من أن يبيعوا اللحى، في أيّ دكّانِ!!
فليس يردعُهُمْ شيءٌ، وليس لهمْ هَمُّ.. سوى جمعِ أموالٍ، وأعوانِ!
ولا أزيدُ.. فإنّ الحالَ مائلةٌ.. وعارياتٌ من الأوراقِ، أَغصاني!
وإنّني، ثَمَّ، لا ظهرٌ، فيغضبَ لي.. وإنّني، ثَمَّ، لا صدرٌ فيلقاني!
ولا ملايين عندي.. كي تُخلّصني من العقابِ.. ولم أُدعَمْ بنسوان!
وسوف يا مصطفى أمضي لآخرتي كما أتَيْتُ: غريبَ الدّارِ، وحداني!
وسوف تنسى رُبى عمّانَ ولْدَنتي فيها.. وسوفَ تُضيع اسمي، وعُنواني!
عمّانُ!! تلك التي قد كنتُ بلبلَها يوماً!.. ولي في هواها نهرُ ألحانِ..
وربّما.. ليس في أرجائها قَمَرٌ إلاّ وأغويتُهُ يوماً، وأغواني!
وربّما.. لم يَدَعْ ثغري بها حجراً إلاّ وقبَّلَهُ تقبيلَ ولهانِ
وربَّما.. ربّما.. يا ليتَ ربّتَها.. تصحو.. فتنقذَها من شرِّ طوفانِ!
وتُطلعَ الزّعتر البريَّ، ثانيةً فيها.. وتشبك ريحاناً، بريحانِ
وتُرجعَ الخُبزَ خبزاً، والنبيذَ كما.. عهدتَه.. في زمانِ الخير «ربّاني»!
وتُرجعَ النّاس ناساً، يذهبونَ معاً.. إلى نفوسهمو.. مِنْ دونِ أضغانِ
فلا دكاكينَ.. تُلهيهم بضاعتُها.. ولا دواوينَ.. تُنسي الواحدَ الثانيَ
ولا.. مجانينَ.. لا يدرونَ أيَّ غدٍ يُخبّئُ الزَّمنُ القاسي.. لأوطاني!!
ماذا أقولُ (أبا وصفي) وقد وضعوا جمراً بكفّي.. وصخراً بين أسناني
وقرّروا أنّني – حتّى ولو نَزَلتْ بي آيةٌ في كتاب الله طلياني!!
وتلك روما.. التي أودى الحريقُ بها تُفتي بكفري.. وتُلغي «صكَّ غفراني!»
وتستبيحُ دمي.. كي لا يحاسبها يوماً.. على ما جنتْ في حقّ إخواني!
وللصّعاليك يومٌ، يرفعون بهِ.. راياتِهم.. فاحذرينا، يا يدَ الجاني!
يا «خالَ عمّارَ».. بعضي لا يُفرّطُ.. في بعضي.. ولو كلّ ما في الكلّ عاداني..
فكيفَ أُلغي تفاصيلي، وأشطبُها..؟ وكيف ينكر نبضي.. نبضَه الثاني؟!
وكيف أَفصلُني عنّي، وأُخرجُني مني.. وما ثمَّ بي إلاّيَ، يغشاني!؟
لقد توحَّدْتُ بي.. حتّى إذا التفتتْ عيني.. رأتني.. وأنَّى سرتُ.. ألقاني!
يا خالَ «عمّارَ»، هذا الزّار أتعبني وهدَّني البحثُ عن نفسي، وأضناني..
ولم أعد أستطيع الفهم.. أُحْجيةٌ وراءَ أحجيةٍ.. والليل ليلانِ!
وإنني ثَمَّ أدري، أنّ ألف يدٍ… تمتدُّ نحوي، تُريدُ «الأحمر القاني!»
فليجرِ.. علَّ نباتاً ماتَ من ظمأٍ.. يحيا بهِ، فيُعزّيني بفقداني!
وتستضيءُ به، عينٌ مُسهّدةٌ فيها – كعين بلادي – نهرُ أحزانِ
وحسبيَ الشعر.. ما لي من ألوذ بهِ سواه.. يلعنهم في كل ديوانِ..
وهو الوليُّ.. الذي يأبى الولاءُ.. له أنْ ينحني قلمي.. إلاّ.. لإيماني…