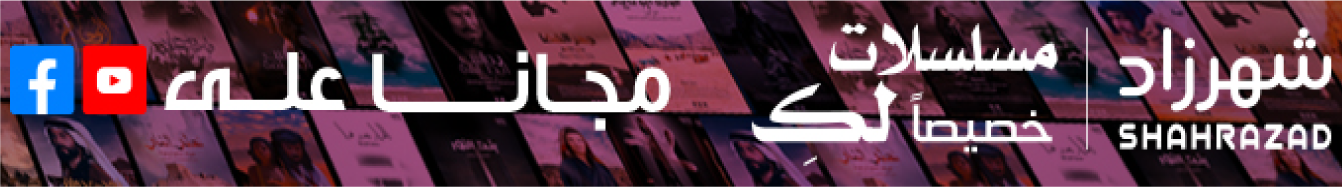باسم سكجها يكتب: في عيد ميلادك يا والدي ابراهيم، أعذرني إذا قصّرت

باسم سكجها
جو 24 :
في عيد ميلاد والدي الثالث والتسعين، الذي يُصادف اليوم، أعيد نشر مقدّمة كتابي "صحافة، ولكن!”، وهي، والكتّاب كلّه، تتعلّق به وبتجربته الغالية، الثرية، وبسيرته العطرة، وأصلاً فسأعيد نشر الكتاب الذي نفد من الأسواق منذ زمن، ضمن كتابي :”إعسار صحافي”، الذي سيصدر قريباً…
رحمك الله يا والدي، وحبيبي إبراهيم علي سكجها، واعذرني إذا قصّرت، ولكنّ ما يشفع لي عندك أنّني حاولت، وما زلت أحاول: أقصى جهدي..
فاتحة الحوار
1
" إذا كان هناك سبب واحد، لتأخر وصول الديمقراطية إلى الاردن، فهو أنتم، أيّها الصحافيون، فقد رضيتم بالاحوال، وكنتم جزءاً منها، وساعدتم، برضوخكم المتواصل، على تطاول الحكومات المتتالية!”
ليس هذا، فقط، ما قاله الدكتور محمد مصالحة، الاستاذ الجامعي، بشكل قطعي، دون أن يسمح لأحد بالرد، أو يترك لنا فرصة للإيضاح، بل أمسك بالمايكروفون، مطولاً، وقال في الصحافة الاردنية، فينا، ما يقال وما لا يقال!
كان ذلك في ندوة متخصصة بالصحافة الاردنية، عقدت في العام ١٩٩١.
وإذا أخذنا "حسن النيّة” عنوانا لما قاله الدكتور، وأظنّها كذلك، فاننا لا نجد تفسيراً سوى انه لا يعرف ما مرّ به الصحافيون الاردنيون، الصحافة الاردنية، خلال عشرات السنوات!
لا يعرف لسببين:
+ لأنه لم يسأل، ويبحث!
+ لتقصير من كبار صحافيينا، لانهم لم يكتبوا، بعد قصّة الصحافة الاردنية… كما عاشوها، وكما جرت فعلا!
2
كنّا صغاراً، وكان مألوفا، في بيتنا، أن يرى ربّه عاطلا عن العمل!
كان يعود الى البيت، ليقول، بسخرية عجيبة: تركت الجريدة!
ويجلس شهوراً، محّولا المنزل الصغير إلى مكتب، يستقبل أسرته الحقيقية، من الزملاء والصحافيين، والحديث، عادة، عن هموم المهنة!
وكان يعود، في وقت لاحق، الى عمل آخر، في جريدة أخرى، لكن العودة الى البيت، أصبحت قدراً لا بد منه، بل لا مفر منه… أبدا!
وما بين العودة الى البيت، والعودة الى العمل، كانت أسئلة الزملاء تلاحقه: لماذا لا تكتب قصّة الصحافة الاردنية… كما عشتها؟
وكان السؤال بالنسبة له كئيباً، تماماً كالاوقات التي يعيشها بعيداً عن عمله الذي كان إليه أقرب إلى العشق، من أيّ شئ آخر.
كان كئيباً، لأنه يحمل، في طيّاته، إحتمال أنه لم يعد قادراً على العطاء، أو انه صار بعيداً عن حبيبة قلبه : الصحافة. لهذا كانت إجابته الدائمة: سأكتب في الوقت المناسب!
لكن الوقت المناسب، للأسف، لم يأت، بل أتى وقت ”غير مناسب”، حيث عاجله المرض، مرض الفراق، فراق الصحافة، قبل أن يأتي وقت الفراق الكبير … فراق الحياة!
3
عاش الوالد أربعاً وستين سنة، قضى منها خمسة وأربعين عاماً في الصحافة!
ولعلّه الصحافي الاردني الوحيد، حتى الآن، الذي لم يعمل، أبداً، في مهنة غيرها، مع أن ما طاله منها، من شقاء، لم يطل غيره من الصحافيين!
ومع هذا، كنت أعجب، وما أزال، كيف ظلّ يعشقها حتى اليوم الأخير من عمره. كنت أعجب، إلى درجة التساؤل، أحياناً: من يُحبّ أكثر ؛ الصحافة.. أم أنا، ولده الوحيد؟!
لكنّ القدر، الذي مارس عليه عمله، بإصرار كبير، طيلة السنوات، إرتدّ، في لحظة مباغتة، عليّ أنا، فأجد نفسي، الآن، أتساءل التساؤل ذاته: من أحب أكثر… الصحافة، أم ولدي الوحيد ابراهيم؟!
وبالفعل، لا أظنني قادراً على إجابة صادقة، تريح الضمير، سوى٬ أن الصحافي يظلم، اول ما يظلم ،أولاده، الذين يكبرون، فيكبر معهم إحساسهم بنقص كبير من الحنان… حنان الاب، الذي إتخّذ له زوجة أخرى… وأولاداً آخرين!
4
وقد مررت، تماما، بهذه الحالة!
إذ كيف يكفيك، من حنان الأب، قُبلة منه، يطبعها على جبينك، وأنت نائم، فجر كلّ يوم، بعد عمل إستغرق من يومه ثماني عشرة ساعة؟!
مررت بهذا، وأكثر، لكنني مررت، أيضاً، بساعات قليلة، توازن هذا كله، وتفوقه حناناً، ومشاعر صادقة، من أولاده الآخرين، الآتين من زوجة أخرى: الصحافة!
ففي السيارة، التي نقلت جثمانه، كان يوسف العلان هو السائق، وكان يُحيط به: أحمد سلامه، عبدالوهاب الزغيلات، يوسف العبسي، خليل المزرعاوي، عماد الحمود، محمد الدعمة، فيصل الشبول، وآخرون.
وجدت نفسي، يومها، محاطاً باخوة مخلصين، أحبوه كما أحببته فعلا.
ووراء السيارة نفسها، كانت المئات من السيارات تحمل الكثيرين ممن عرفوه وأحبوه، والكثيرين الكثيرين ممن سمعوا عنه، فقدّروه، وها هم يحضرون لحظات وداعه الأخيرة.
وكانت الجنازة، التي لاقت برجل مثله، ردّا سافراً على تساؤل ظلّ يلازمني سنوات وسنوات: ما هذا الجحود بحق هذا الرجل، الذي قدّم الكثير، ولم يرى سوى القليل؟
وكانت رداً ”جميلاً” يؤكد أنّ الصحافي رجل عام… عائلته كبيرة، أكبر بكثير من زوجته وأطفاله!
لكن تساؤلاً آخر، قفز الى ذهني: هل كان عليه أن يموت، حتى يعرف حجم حبّه وتقديره؟!
5
وكما وجد نفسه، كثيراً، عاطلاً عن العمل، وجدت نفسي كذلك، في صيف ٩٢، فعدت إلى أوراق الوالد، المنشورة وغير المنشورة، لأكتشف انها أساس متين لسرد قصّة الصحافة، أو في القليل، جزء منها.
وأثناء العمل، كنت اجد نواقص، هنا وهناك، ولاستكمالها، رأيت أن أوسع مجال البحث، فالتقيت مع بعض مَنْ عاشوا وعايشوا كل حدث.
ولان للحقائق أكثر من وجه، كانت الرواية تتباين، وتختلف، وتتناقض احيانا، لهذا فالامر كان يصل إلى حد الأحباط، في الوصول الى الحقيقة الكاملة.
ولكن المنطق، يظل هو المنطق، وعلى أساسه، فقط، كنت أنحاز الى هذا الرأي أو ذاك… أمّا ما كان مدعوما بالوثيقة، فيظل هو الاصل… وهذا ما اعتمدته، في أغلب الاحوال.
وعلى اية حال، فإنني، هنا، لا أدّعي الوصول الى الحقيقة الكاملة، فَمَنْ منا يستطيع أن يفعل؟
لكنني، في واقع الآمر، حاولت الاقتراب منها، بقدر ما سمحت لي المعلومات… والصراحة!
6
وفي مرحلة من الكتابة، حين غرقت في بحر من الاوراق المهمّة، التي تكشف، أحياناً، ما لا يعرفه الا القليلون، وحُفظت في الادراج المغلقة، كنت استشير مَنْ أثق برأيهم. وكان محبطاً جداً، أن أستمع، مثلاً، الى أحد كبار صحافيينا يهمس في أذني: "لسنا نعيش في أميركا.. ولا حتى مصر، فالأردن لا يحتمل نشر الامور، كما جرت فعلا، وسوف تخلق لك أعداء أكثر مما تتصور!”
وكان مُحبطاً، أكثر، أن أستمع إلى واحد من كبار صحافيينا، يقول لي: "فتح الملفات أمر لا تحمد عقباه في بلادنا” ولكن، وللحق، في مقابل هذا وذاك، كنت أجد الكثير ممن يشجعونني، ويحثونني على الاستمرار، بل ويفتحون لي ملفاتهم الشخصية، وقلوبهم، وعقولهم.
وفي الحقيقة، فانّ ثمة قناعة تكونت لدي، قبل الآن بالطبع، مفادها: أن من حق الناس أن تعرف الامور كما جرت، وأن تُشكّل قناعاتها على هذا الاساس.
وأظن، مُحتملاً أي إثم ناتج عن هذا الكلام، أنني مارست، خلال السنوات القليلة، في المهنة، هذه القناعات، لهذا كان لي نصيبي، أيضا، من المتاعب، ومن الحروق، التي تطال قشرة الجلد، ولا تصل اى اللحم، فيعود الجلد نضراً بعد حين… ليس طويلا!
فقد كتبت عن أشخاص، ومؤسسات، ما لم يُرضهم، في أول الامر، وكانت تصل المسائل، أحيانا، الى التهديد بالضرب، وأحيانا أخرى بأكثر من ذلك! لكن الايام كانت تمرّ، فلا يأتي من يضرب، أو مَنْ يفعل أكثر… بل إن كثيراً ممن هدّدوا، عادوا أصدقاء، كما كانوا، دون أن أغير قناعاتي في ما كتبت!
7
وأكاد، بناء على ذلك، وعلى غيره ايضاً، أنْ اسمع منذ الآن، مَنْ يشكك في ما كتبت من أصله، أو مَنْ يشكك في صحة الرواية، أو تلك، أو من يُخرج رواية عن سياقها، أو من يزيد من الروايات ما يدعم فكرة موجودة، أو من يؤيد الرواية… أو من يصحح شيئاً، أو من يطلب أكثر!
أقول، باختصار: أكاد اسمع، منذ الآن، من يؤيد، ومن يعارض!
ولهؤلاء، جميعا، سأقدم الشكر، مطالباً بالكتابة، على أساس ان ما كتبت ليس سوى بداية حوار، عنوانه: الصحافة الاردنية، التي هي عنوان الديمقراطية، التي إرتضينا، جميعا، على ما يبدو، أن تكون عنوان الحياة السياسية الاردنية، في المستقبلين القريب والبعيد، وأي مستقبل لا يتأسس على فهم تجربة الماضي، مستقبل بلا مستقبل… بلا أفق!
8
وأخيراً، وآخراً ايضا، فقد تزاوجت في هذا الكتاب غايتان؛ واحدة شخصية، وأخرى عامة.
والشخصية، كما هو متوقع؛ أن أفي الرجل، والدي، وأستاذي المرحوم ابراهيم سكجها، حقّه، في نشر غير المعروف عن حياته، التي قد تكون جوانب مهمة، من حياة الصحافة الاردنية والفلسطينية.
وسوف أسجل، هنا، مفارقة تؤشر الى شيء من الخلل، الذي كانت عليه الصحافة، ونتمنى ان تكون خرجت منه فعلا:
في بدايات العام ٨٩، بادرت صحيفة أردنية، كان الوالد من مؤسسيها، إلى تكليف الزميل طلعت شناعة، بتسجيل يوميات الوالد، ضمن سلسلة ذكريات تنشرها الصحيفة، الوالد أعطى شناعة ما يريد، لكن إدارة الصحيفة لم تنشره، مع انها نشرت للآخرين، بسبب خلافات شخصية!
وهنا، في بداية الكتاب، فصل يحمل عنوان: "حديث الذكريات”، إستأذنت الزميل بنشر ما سجله من الوالد، بالاضافة الى ما كان كتبه في مواقع أخرى، ويتعلق بتاريخ الصحافة.
وفي الغاية الثانية، العامة، لن أقول، الآن، سوى إن كتابي "فاتح حوار”، أتمنى أن تشارك فيه كافة الأطراف، بحيث تكون حصيلته، حصيلة الحوار، التاريخ الكامل للصحافة الاردنية.