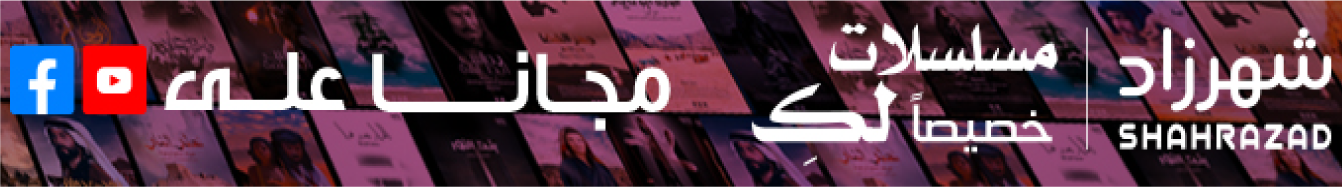عاتبوا ولا تخاصموا

فهمي هويدي
جو 24 : لماذا حين تهاجم السياسة الأمريكية وينتقد أو يجرح الرئيس الأمريكي لا يغضب أحد في الولايات المتحدة، ولا نسمع صوتا هناك يقول إن الشعب الأمريكي أهين أو أن الدولة تتعرض لمؤامرة خارجية، أما حين يحدث ذلك مع بلد عربي فإن نقد الرئاسة أو السياسة يعد على الفور إهانة للشعب ومؤامرة تستهدف الدولة؟
ليس الأمر مقصورا على الولايات المتحدة وحدها، ولكن ذلك حاصل أيضا في مختلف الدول الديمقراطية، لكني قصدت ذكر السياسة الأمريكية والرئيس الأمريكي لأنهما الأوفر حظا في النقد والتجريح في مصر هذه الأيام، خصوصا في ظل الشائعات التي تتحدث عن تآمر واشنطن مع الإخوان وعلاقة الرئيس باراك أوباما بالتنظيم الدولي.
لست في مجال تحري صحة الشائعات وبالتأكيد ليس عندي أي دفاع عن الإدارة الأمريكية ورئيسها، لكن ما همني في الموضوع أن التنديد بالاثنين في الإعلام ربما أثر على أجواء العلاقات بين القاهرة وواشنطن، ولكنه لم يؤثر على أوجه التعاون ولا خطوط الاتصال شبه اليومية بين الطرفين. فلا تعطلت مصالح ولا سحب سفير ولا قطعت الوشائج أو هدمت الجسور. وهذه النقطة الأخيرة هي التي تعنيني في اللحظة الراهنة، لأنها تجسد المعنى الذي أريد أن أتوقف عنده في محاولة لتحليله وتشريحه.
في هذا الصدد فإنني أزعم أن الفرق بين صدى نقد السياسات عندهم وعندنا في العالم العربي يكمن في اختلاف النظر إلى مفهوم الدولة لدى الطرفين. ذلك أن أحد تعريفات الدولة في النظم الديمقراطية أنها ذلك الكيان الذي تديره المؤسسات المنتخبة من الشعب ويحتكم فيه إلى القانون. أما النظم غير الديمقراطية فالدولة فيها تختزل في رئيسها والنظام الذي أقامه، الأمر الذي يسوغ لي أن أقول إن الدولة في تلك النظم الأخيرة تدار بعقل القبيلة التي يقودها الشيخ ويحتكم فيها إلى العرف. ولا أريد أن أقلل من شأن قيمة القبيلة في التشكيل الاجتماعي، لأن لها فضائلها واجبة الاحترام، لكنني أتحدث عن اقتباس نهج القبيلة في إدارة الدولة. ذلك أن رأس الدولة في الأنظمة الديمقراطية فرد تنتخبه الأغلبية يؤدي وظيفة من خلال المؤسسات والأجهزة البيروقراطية ثم يمضي إلى حال سبيله في أوان يحدده القانون. إن شئت فقل إنه عابر ومتغير في حين أن مؤسسات المجتمع هي الباقية. أما رأس القبيلة فهو من «ثوابتها»، هو رمزها وشرفها وهو وسلالته باقون ما بقيت القبيلة. بسبب من ذلك فإن هجاء رئيس الدولة الديمقراطية أو انتقاده هو ونظامه، لا يغير من واقع الحال شيئا. أما رئيس القبيلة فهو خدش لرمزها وكبريائها وعدوان على كرامتها، تحشد الحشود لرده وتنزف الدماء لإزالة آثاره.
الذاكرة العربية تحفل بالقصص والروايات التي تدلل على أن بلادنا لا تزال تدار بعقلية القبيلة رغم أنها تحمل اسم الدولة وشكلها. فشعار «الأسد إلى الأبد» في سوريا حول الرئيس إلى شيخ وقدر مكتوب على البلد. ومعمر القذافي حين قطع علاقته وسحب استثمارات بلاده من سويسرا لأن ابنه عوقب على جرم ارتكبه، فإنه تصرف بعقلية شيخ القبيلة وليس رئيس الدولة. والسادات حين اختلف معه فإنه قطع العلاقات معه بحيث أغلق الطريق البري الذي يصل بين البلدين لعدة سنوات، وكان ذلك سببا في معاناة وتعذيب ألوف المصريين العاملين في ليبيا، إذ أصبحوا مضطرين إلى الذهاب إليها بالمطارات عبر العاصمة اليونانية أثينا.
لا أريد أن أسترسل في سرد مثل هذه القصص، لأنني أريد أن أتوقف عما جرى بين مصر وتركيا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في طرد السفير التركي من القاهرة، وألقى بظلاله على كل أوجه العلاقات بين البلدين. وأسجل ابتداء أمرين: الأول أنني لا أؤيد بعض التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء التركي، واتسمت بالانفعال في نقد الوضع المستجد في مصر، لكنني أزعم أن احتواءها بالدبلوماسية التي تعاتب ولا تخاصم، كان أصوب وأحكم. والأمر الثاني أن بعض اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الإخوان وتنظيمهم الدولي في تركيا لمناهضة النظام الجديد (وهي جوهر المشكلة) عقدت نظائرها في عواصم أوروبية أخرى (جنيف ولندن مثلا) وسكتت عليها القاهرة ولم تحسبها على أنظمة تلك الدول، لأن أوضاعها القانونية سمحت بها.
إن عقل الدولة في الموقف الذي نحن بصدده كان ينبغي أن يضع في الحسبان حجم الأضرار السياسية والاقتصادية التي تترتب على مخاصمة دولة بأهمية تركيا، خصوصا في الظرف الراهن الذي تتغير فيه الموازين ويعاد رسم خرائط المنطقة، وهي المصالح العليا وثيقة الصلة بدور مصر وأمنها القومي. إلا أننا وجدنا منطقا مقلوبا في ظله بقي سفير الدولة العبرية التي خاصمت الوطن والشعب والأمة في القاهرة، في حين طرد سفير الدولة التي انتقدت النظام خلال 24 ساعة، وهو ما لا يسيء إلى الدولة فحسب ولكنه يسيء للقبيلة أيضا.
(السبيل)
ليس الأمر مقصورا على الولايات المتحدة وحدها، ولكن ذلك حاصل أيضا في مختلف الدول الديمقراطية، لكني قصدت ذكر السياسة الأمريكية والرئيس الأمريكي لأنهما الأوفر حظا في النقد والتجريح في مصر هذه الأيام، خصوصا في ظل الشائعات التي تتحدث عن تآمر واشنطن مع الإخوان وعلاقة الرئيس باراك أوباما بالتنظيم الدولي.
لست في مجال تحري صحة الشائعات وبالتأكيد ليس عندي أي دفاع عن الإدارة الأمريكية ورئيسها، لكن ما همني في الموضوع أن التنديد بالاثنين في الإعلام ربما أثر على أجواء العلاقات بين القاهرة وواشنطن، ولكنه لم يؤثر على أوجه التعاون ولا خطوط الاتصال شبه اليومية بين الطرفين. فلا تعطلت مصالح ولا سحب سفير ولا قطعت الوشائج أو هدمت الجسور. وهذه النقطة الأخيرة هي التي تعنيني في اللحظة الراهنة، لأنها تجسد المعنى الذي أريد أن أتوقف عنده في محاولة لتحليله وتشريحه.
في هذا الصدد فإنني أزعم أن الفرق بين صدى نقد السياسات عندهم وعندنا في العالم العربي يكمن في اختلاف النظر إلى مفهوم الدولة لدى الطرفين. ذلك أن أحد تعريفات الدولة في النظم الديمقراطية أنها ذلك الكيان الذي تديره المؤسسات المنتخبة من الشعب ويحتكم فيه إلى القانون. أما النظم غير الديمقراطية فالدولة فيها تختزل في رئيسها والنظام الذي أقامه، الأمر الذي يسوغ لي أن أقول إن الدولة في تلك النظم الأخيرة تدار بعقل القبيلة التي يقودها الشيخ ويحتكم فيها إلى العرف. ولا أريد أن أقلل من شأن قيمة القبيلة في التشكيل الاجتماعي، لأن لها فضائلها واجبة الاحترام، لكنني أتحدث عن اقتباس نهج القبيلة في إدارة الدولة. ذلك أن رأس الدولة في الأنظمة الديمقراطية فرد تنتخبه الأغلبية يؤدي وظيفة من خلال المؤسسات والأجهزة البيروقراطية ثم يمضي إلى حال سبيله في أوان يحدده القانون. إن شئت فقل إنه عابر ومتغير في حين أن مؤسسات المجتمع هي الباقية. أما رأس القبيلة فهو من «ثوابتها»، هو رمزها وشرفها وهو وسلالته باقون ما بقيت القبيلة. بسبب من ذلك فإن هجاء رئيس الدولة الديمقراطية أو انتقاده هو ونظامه، لا يغير من واقع الحال شيئا. أما رئيس القبيلة فهو خدش لرمزها وكبريائها وعدوان على كرامتها، تحشد الحشود لرده وتنزف الدماء لإزالة آثاره.
الذاكرة العربية تحفل بالقصص والروايات التي تدلل على أن بلادنا لا تزال تدار بعقلية القبيلة رغم أنها تحمل اسم الدولة وشكلها. فشعار «الأسد إلى الأبد» في سوريا حول الرئيس إلى شيخ وقدر مكتوب على البلد. ومعمر القذافي حين قطع علاقته وسحب استثمارات بلاده من سويسرا لأن ابنه عوقب على جرم ارتكبه، فإنه تصرف بعقلية شيخ القبيلة وليس رئيس الدولة. والسادات حين اختلف معه فإنه قطع العلاقات معه بحيث أغلق الطريق البري الذي يصل بين البلدين لعدة سنوات، وكان ذلك سببا في معاناة وتعذيب ألوف المصريين العاملين في ليبيا، إذ أصبحوا مضطرين إلى الذهاب إليها بالمطارات عبر العاصمة اليونانية أثينا.
لا أريد أن أسترسل في سرد مثل هذه القصص، لأنني أريد أن أتوقف عما جرى بين مصر وتركيا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في طرد السفير التركي من القاهرة، وألقى بظلاله على كل أوجه العلاقات بين البلدين. وأسجل ابتداء أمرين: الأول أنني لا أؤيد بعض التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء التركي، واتسمت بالانفعال في نقد الوضع المستجد في مصر، لكنني أزعم أن احتواءها بالدبلوماسية التي تعاتب ولا تخاصم، كان أصوب وأحكم. والأمر الثاني أن بعض اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الإخوان وتنظيمهم الدولي في تركيا لمناهضة النظام الجديد (وهي جوهر المشكلة) عقدت نظائرها في عواصم أوروبية أخرى (جنيف ولندن مثلا) وسكتت عليها القاهرة ولم تحسبها على أنظمة تلك الدول، لأن أوضاعها القانونية سمحت بها.
إن عقل الدولة في الموقف الذي نحن بصدده كان ينبغي أن يضع في الحسبان حجم الأضرار السياسية والاقتصادية التي تترتب على مخاصمة دولة بأهمية تركيا، خصوصا في الظرف الراهن الذي تتغير فيه الموازين ويعاد رسم خرائط المنطقة، وهي المصالح العليا وثيقة الصلة بدور مصر وأمنها القومي. إلا أننا وجدنا منطقا مقلوبا في ظله بقي سفير الدولة العبرية التي خاصمت الوطن والشعب والأمة في القاهرة، في حين طرد سفير الدولة التي انتقدت النظام خلال 24 ساعة، وهو ما لا يسيء إلى الدولة فحسب ولكنه يسيء للقبيلة أيضا.
(السبيل)