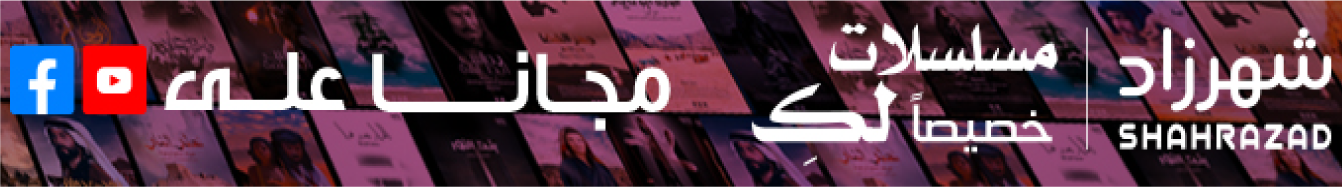بـشــار أم «الإرهــابـيـون»؟!

ياسر الزعاترة
جو 24 : كان مثيرا للسخرية ذلك الإعلان الأميركي عن وقف الدعم للجيش السوري الحر، بسبب هيمنة “الجماعات المتطرفة” على بعض مواقعه، وهو دعم لم يكن يتعدى بضع عشرات من الملايين لا يصل منها شيء ذو قيمة؛ ضمن ما يسمى أسلحة غير فتاكة، والسبب هو سيطرة الجبهة الإسلامية على مواقع لهيئة أركان الجيش الحر عند معبر باب الهوى.
منذ شهور وجدل المعتدلين والمتطرفين في سوريا يتصاعد في الأوساط الدولية والإقليمية، لاسيما بعد ظهور الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي ردت عليه جبهة النصرة بإعلان نسبتها إلى القاعدة، وموقف الظواهري المؤيد، ورفض البغدادي، فضلا عن ممارسات تنسب للدولة وقوىً أخرى تشير إلى بناء قواعد وإمارات تثير مخاوف لدى أطراف كثيرة.
وإذا تذكرنا أن للنظام في دمشق صلة مباشرة بدفع الثورة نحو المسار المسلح، اعتقادا منه بأن ذلك سيسهّل القضاء عليها، وصولا إلى تحويلها من الإطار الثوري المسلح التقليدي، إلى الإطار الجهادي، وبالطبع عبر إطلاق بعض المعتقلين الجهاديين في سجونه، والذين كان غدر بهم ووضعهم في السجون بعدما تحالف معهم في العراق، إذا تذكرنا ذلك كله، فإن هذا الملف يغدو أكثر أهمية، وفي حاجة إلى الكثير من التوقف لقراءة تداعياته على الثورة السورية.
من الناحية العسكرية، يمكن القول، إن الجهد الذي بذلته الفصائل الإسلامية المقاتلة في الثورة السورية هو الأبرز دون شك، إن كانت الفصائل التي تصنف معتدلة، وهي تلك التي انضوت مؤخرا في إطار ما عرف بالجبهة الإسلامية السورية، أم تلك التي تصنف ضمن خط القاعدة، وهي جبهة النصرة أولا، والتي باتت تصنف بدورها على أنها أقل تشددا من الدولة الإسلامية في العراق والشام بقيادة أبو بكر البغدادي.
ولولا الدعم المباشر والواسع النطاق الذي تلقاه النظام من الحرس الثوري وحزب الله، وكتائب شيعية خارجية، لصارت الهزيمة أقرب إليه من حبل الوريد، وهو ما اعترفت به دوائر من حزب الله على كل حال، بما في ذلك حسن نصر الله، وإن قال ذلك في سياق من تبرير تدخله حزب في القتال للحيلولة دون تحول سوريا إلى عراق آخر.
من الناحية السياسية، يمكن القول، إن الوجه الإسلامي للثورة السورية، بخاصة الجزء “المتشدد” منه كما يراه الغرب وأطراف عربية وإقليمية أخرى قد أضرَّ من الناحية العملية بالثورة، وحشرها بمرور الوقت في إطار محدد، رغم محاولات الآخرين تقديم وجه مختلف لها، وبتصاعد نفوذ المجموعات الجهادية، مع بعض الممارسات التي يجري استثمارها، بل تضخيمها أحيانا بات الوضع أكثر سوءا.
ما ينبغي أن يقال هنا هو، إن الموقف الأميركي والغربي لم يكن مساندا من الناحية العملية للثورة، وتبعا لحسابات إسرائيلية أرادت إطالة أمد النزاع لتدمير البلد، واستنزاف إيران وحزب الله وتركيا، والربيع العربي أيضا، لكن الوجه المشار إليه، ما لبث أن سهَّل المخطط.
الآن، وفي ظل ما جرى، يُطرح سؤال كبير حول تأثير هذا الوضع على الثورة السورية، بخاصة على الحل السياسي، وما إذا كانت إستراتيجية النظام، ومن ورائه إيران في دفع الثورة نحو البعد الإسلامي “المتشدد” تحت وطأة المذابح والقتل والتطييف، ما إذا كانت نجحت في تحقيق الهدف المطلوب ممثلا في حصارها وعزلها، وصولا إلى إنهائها.
واللافت في هذا السياق، وتعرضنا إليه غير مرة هو ميل النظام وإيران وحلفائها إلى استخدام فزاعة الإرهاب، وتقديم أنفسهم بوصفهم رأس الحربة في الحرب ضده، وهي بضاعة تجد رواجا في الأوساط الغربية كما يبدو.
ما يمكن قوله هنا هو، إن النتيجة التي أرادها النظام وحلفاؤه ليست برسم النجاح بالضرورة، ذلك أن المخاوف التي بدأت تطرح نفسها من تمدد الجماعات الجهادية، باتت تدفع نحو تفكير روسي أميركي آخر؛ “لقاء مصالح”، كما ذهبت فورين بوليسي في تقرير نشرته في عددها الصادر الأربعاء (11/12).
لقد أراد النظام أن يقول للعالم، بل قال بالفعل؛ “إما أنا، وإما داعش”، أي الدولة الإسلامية في العراق والشام، لكن جواب هذا السؤال لن يكون بالضرورة (أنت)، لأن قدرته على هزيمة الثورة (هنا توضع جميعا في سلة واحدة، ولييس فريقا منها فقط) ليست مؤكدة، فيما يزداد نفوذ الجماعة التي يخشون منها؛ لأن قدرتها على الاستقطاب في أجواء طائفية رهيبة تبدو أكثر فاعلية من سواها.
من هنا، فإن ما قد يختاره الغرب، وتؤيده روسيا هو إيجاد حل سياسي ترضى به المعارضة السورية، وتقبل تبعا له في دخول معركة تحجيم للفريق المرفوض من الخارج، أو عزله وإقناعه بوقف القتال، وهو ما يعني أن أحلام النظام لن تتحقق، وقد تكون النتيجة هي التضحية برأس بشار، وإن بقيت البنية الأساس للنظام قائمة بقدر ما.
في مؤتمر جنيف المقبل، ستتبدى ملامح الإجابة عن هذا السؤال، وإن بدا من الصعب أن تحسم تماما، وسنرى مدى مرونة روسيا في قبول حل معقول، هي التي يعيش رئيسها (بوتين) هواجس الجهاديين أكثر من سواه بكثير.
مشهد بالغ التعقيد، يصعب الجزم بأي من مآلاته التفصيلية، فضلا عن الزمن الذي سيتسغرقه فرض أي حل مهما كان، وأيا كان تصنيفه من قبل طرفي النزاع، فضلا عن حسم لا يبدو قريبا وفق معظم المؤشرات المتاحة.
(الدستور)
منذ شهور وجدل المعتدلين والمتطرفين في سوريا يتصاعد في الأوساط الدولية والإقليمية، لاسيما بعد ظهور الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي ردت عليه جبهة النصرة بإعلان نسبتها إلى القاعدة، وموقف الظواهري المؤيد، ورفض البغدادي، فضلا عن ممارسات تنسب للدولة وقوىً أخرى تشير إلى بناء قواعد وإمارات تثير مخاوف لدى أطراف كثيرة.
وإذا تذكرنا أن للنظام في دمشق صلة مباشرة بدفع الثورة نحو المسار المسلح، اعتقادا منه بأن ذلك سيسهّل القضاء عليها، وصولا إلى تحويلها من الإطار الثوري المسلح التقليدي، إلى الإطار الجهادي، وبالطبع عبر إطلاق بعض المعتقلين الجهاديين في سجونه، والذين كان غدر بهم ووضعهم في السجون بعدما تحالف معهم في العراق، إذا تذكرنا ذلك كله، فإن هذا الملف يغدو أكثر أهمية، وفي حاجة إلى الكثير من التوقف لقراءة تداعياته على الثورة السورية.
من الناحية العسكرية، يمكن القول، إن الجهد الذي بذلته الفصائل الإسلامية المقاتلة في الثورة السورية هو الأبرز دون شك، إن كانت الفصائل التي تصنف معتدلة، وهي تلك التي انضوت مؤخرا في إطار ما عرف بالجبهة الإسلامية السورية، أم تلك التي تصنف ضمن خط القاعدة، وهي جبهة النصرة أولا، والتي باتت تصنف بدورها على أنها أقل تشددا من الدولة الإسلامية في العراق والشام بقيادة أبو بكر البغدادي.
ولولا الدعم المباشر والواسع النطاق الذي تلقاه النظام من الحرس الثوري وحزب الله، وكتائب شيعية خارجية، لصارت الهزيمة أقرب إليه من حبل الوريد، وهو ما اعترفت به دوائر من حزب الله على كل حال، بما في ذلك حسن نصر الله، وإن قال ذلك في سياق من تبرير تدخله حزب في القتال للحيلولة دون تحول سوريا إلى عراق آخر.
من الناحية السياسية، يمكن القول، إن الوجه الإسلامي للثورة السورية، بخاصة الجزء “المتشدد” منه كما يراه الغرب وأطراف عربية وإقليمية أخرى قد أضرَّ من الناحية العملية بالثورة، وحشرها بمرور الوقت في إطار محدد، رغم محاولات الآخرين تقديم وجه مختلف لها، وبتصاعد نفوذ المجموعات الجهادية، مع بعض الممارسات التي يجري استثمارها، بل تضخيمها أحيانا بات الوضع أكثر سوءا.
ما ينبغي أن يقال هنا هو، إن الموقف الأميركي والغربي لم يكن مساندا من الناحية العملية للثورة، وتبعا لحسابات إسرائيلية أرادت إطالة أمد النزاع لتدمير البلد، واستنزاف إيران وحزب الله وتركيا، والربيع العربي أيضا، لكن الوجه المشار إليه، ما لبث أن سهَّل المخطط.
الآن، وفي ظل ما جرى، يُطرح سؤال كبير حول تأثير هذا الوضع على الثورة السورية، بخاصة على الحل السياسي، وما إذا كانت إستراتيجية النظام، ومن ورائه إيران في دفع الثورة نحو البعد الإسلامي “المتشدد” تحت وطأة المذابح والقتل والتطييف، ما إذا كانت نجحت في تحقيق الهدف المطلوب ممثلا في حصارها وعزلها، وصولا إلى إنهائها.
واللافت في هذا السياق، وتعرضنا إليه غير مرة هو ميل النظام وإيران وحلفائها إلى استخدام فزاعة الإرهاب، وتقديم أنفسهم بوصفهم رأس الحربة في الحرب ضده، وهي بضاعة تجد رواجا في الأوساط الغربية كما يبدو.
ما يمكن قوله هنا هو، إن النتيجة التي أرادها النظام وحلفاؤه ليست برسم النجاح بالضرورة، ذلك أن المخاوف التي بدأت تطرح نفسها من تمدد الجماعات الجهادية، باتت تدفع نحو تفكير روسي أميركي آخر؛ “لقاء مصالح”، كما ذهبت فورين بوليسي في تقرير نشرته في عددها الصادر الأربعاء (11/12).
لقد أراد النظام أن يقول للعالم، بل قال بالفعل؛ “إما أنا، وإما داعش”، أي الدولة الإسلامية في العراق والشام، لكن جواب هذا السؤال لن يكون بالضرورة (أنت)، لأن قدرته على هزيمة الثورة (هنا توضع جميعا في سلة واحدة، ولييس فريقا منها فقط) ليست مؤكدة، فيما يزداد نفوذ الجماعة التي يخشون منها؛ لأن قدرتها على الاستقطاب في أجواء طائفية رهيبة تبدو أكثر فاعلية من سواها.
من هنا، فإن ما قد يختاره الغرب، وتؤيده روسيا هو إيجاد حل سياسي ترضى به المعارضة السورية، وتقبل تبعا له في دخول معركة تحجيم للفريق المرفوض من الخارج، أو عزله وإقناعه بوقف القتال، وهو ما يعني أن أحلام النظام لن تتحقق، وقد تكون النتيجة هي التضحية برأس بشار، وإن بقيت البنية الأساس للنظام قائمة بقدر ما.
في مؤتمر جنيف المقبل، ستتبدى ملامح الإجابة عن هذا السؤال، وإن بدا من الصعب أن تحسم تماما، وسنرى مدى مرونة روسيا في قبول حل معقول، هي التي يعيش رئيسها (بوتين) هواجس الجهاديين أكثر من سواه بكثير.
مشهد بالغ التعقيد، يصعب الجزم بأي من مآلاته التفصيلية، فضلا عن الزمن الذي سيتسغرقه فرض أي حل مهما كان، وأيا كان تصنيفه من قبل طرفي النزاع، فضلا عن حسم لا يبدو قريبا وفق معظم المؤشرات المتاحة.
(الدستور)