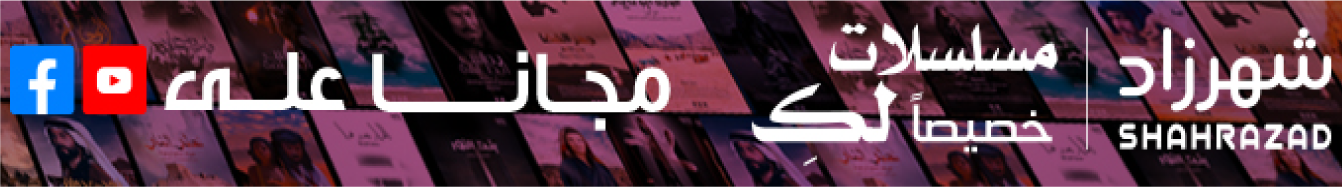كيف أصبح أردوغان شأنا عربيا؟

ياسر الزعاترة
جو 24 : إذا عدنا بضع سنوات ليست بعيدة إلى الوراء، فسيكون بوسعنا القول، إن الوضع في تركيا لم يكن يحظى بكثير اهتمام في الأوساط العربية والإسلامية عموما، فالحزب الحاكم بزعامة أردوغان كان يطارد العضوية في الاتحاد الأوروبي، ولم يثر أي إشكال يذكر مع الكيان الصهيوني، حيث ورث عن حكومات سابقة علاقات أمنية وإستراتيجية واقتصادية واسعة النطاق معه، فيما لم يكن هو (أي أردوغان) يتدخل في الشؤون العربية عموما، بل إن سياسة الحزب الخارجية كان شعارها كما يعرف الجميع هو “صفر مشاكل”، وكانت العلاقة مع سوريا تحديدا هي الأكثر تميزا (كذلك مع إيران التي كانت تركيا هي ملاذها الاقتصادي في ظل العقوبات الدولية). أما الدول العربية الأخرى، فكانت العلاقة معها إيجابية في العموم؛ على تفاوت بين بلد وآخر.
على أن ذلك لم يلبث أن تغير منذ 4 سنوات تقريبا، تحديدا منذ 31 أيار/مايو 2010، ذلك التاريخ الذي شهد مجزرة الصهاينة بحق سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة نحو قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه.
كانت ردة فعل أردوغان على المجزرة التي استشهد خلالها 9 أتراك قوية جدا، ومنذ تلك اللحظة دخلت العلاقة مع الكيان الصهيوني مرحلة من التوتر، فيما سبقتها حادثة الاشتباك اللفظي مع رئيس الكيان الصهيوني (بيريز) في دافوس، وهي كانت علامة فارقة أيضا، لكنها، ومعها حادثة مرمرة كانت بمثابة إعلان دخول لأردوغان إلى المجال العربي من بابه العريض، وبالطبع في ظل خضوع الوضع العربي لما يعرف بمحور الاعتدال بقيادة مصرية سعودية.
نفتح قوسا هنا لنشير إلى أن ردة فعل أردوغان الشديدة على مجزرة السفينة مرمرة كانت نقطة الفراق بينه وبين رجل الدين الصوفي “فتح الله غولن” الذي يعيش في أمريكا منذ سنوات بعيدة، وتربطه علاقات جيدة بالمحافظين الجدد الذين يرتبطون بدورهم بعلاقة حميمة مع دولة الاحتلال، وكانت المرة الأولى التي يوجه فيها “غولن” المُقل في التصريح والظهور انتقادات لأردوغان، معتبرا أن ردة فعله على حادثة السفينة كانت أكبر من اللازم.
لم تكد هذه القضية تهدأ، حتى جاء الربيع العربي من خلال ثورة تونس، ثم مصر واليمن وليبيا، ومن ثم سوريا، وهنا وجد أردوغان أن سياسة “صفر مشاكل” قد اصطدمت بالجدار المسدود، وها هو يضطر إلى اتخاذ موقف سياسي مما يجري، فإما أن ينحاز إلى لغة المصالح والبزنس، وإما أن ينحاز إلى لغة المبادئ، لاسيما أن بعض الاختبارات كانت محرجة، فالعلاقة التجارية مع ليبيا كانت قوية، والاقتصادية والسياسية مع سوريا كانت أكثر قوة، ولعل ذلك هو ما دفعه إلى التردد بعض الشيء قبل أن يحسم الموقف لصالح المباديء، وينحاز بكل قوة، وبشكل كلّفه الكثير، ولا يزال، إلى جانب الشعب السوري، وقبل ذلك الشعب الليبي والمصري، ومن ثم إلى فكرة الربيع العربي برمتها.
هنا بدأ هجوم القوى السياسية اليسارية والقومية العربية يشتد عليه، وأصبح بنظرهم “السلطان العثماني الذي يسعىلاستعادة إرث أجداده”، فيما كان في بعض تجليات الخطاب عميلا للإمبريالية والصهيونية، لكن اللافت هنا أن الهجوم عليه لم يتوقف عند هؤلاء، بل امتد ليشمل أنظمة عربية تقليدية من تلك التي وقفت ضد ربيع العرب، وهذه تحديدا لم تكتف بالحملة الإعلامية، بل شارك بعضها في مؤامرات ضده على أكثر من صعيد، ووصل الحال حد التواصل مع قوى داخلية مثل الأكراد لأجل تحريضهم على نسف اتفاقهم التاريخي معه، فيما كان لسوريا وإيران تواصلها مع حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل العلويون كتلة كبيرة من جمهوره وأنصاره. وكانت العلامة الفارقة في تصعيد الحملة المناهضة لأردوغان هي وقفته ضد الانقلاب في مصر الذي حظي بدعم غير مسبوق من قبل أنظمة الثورة المضادة، ومن قبل قوى اليسار والقوميين أيضا، وكانت وقفة مشهودة خلت حتى من الحساب السيسي، هي التي كان يمكن أن تكون أكثر اعتدالا في ظل وضوح صمود الانقلاب بسبب خلل ميزان القوى الداخلي والخارجي لصالحه.
هذا الهجوم الشرس على أردوغان من قبل يساريين وقوميين، وتاليا من قبل أنظمة الثورة المضادة، ومن ثم ظهور المؤامرة الكبيرة عليه من قبل جماعة غولن، جعلت من الرجل محط أنظار الجماهير العربية، ودفعها نحو الانشغال بمعاركه، بل أصبحت خائفة عليه إلى حد كبير، لاسيما أن شعار إلحاقه بمرسي قد بدأ يتردد في الكثير من الأوساط العربية الرسيمة المناهضة للثورات وربيع العرب.
لكن ما ينبغي تذكره أيضا هو أن الحشد المذهبي في المنطقة، وشعور الغالبية السنيّة بالغطرسة الإيرانية قد أضاف اهتماما كبيرا بالشأن التركي، وحيث شعرت تلك الغالبية بإمكانية أن تشكل تركيا عنصر توازن مع إيران على مستوى الإقليم.
من هنا جاء الاهتمام الكبير بالانتخابات البلدية الأخيرة، بوصفها استفتاءً على الرجل، بخاصة بعد سلسلة تسريبات سعت بكل قوة إلى تشويهه وقادة حزبه واتهامهم بالفساد، ولذلك أيضا جاءت الفرحة الكبيرة التي عاشتها جماهير الأمة المنحازة للثورات بفوزه الكبير، فيما كانت الخيبة من نصيب كل تلك الفئات في مصر، وكذا أنظمة الثورة المضادة، إلى جانب نظام بشار وتحالفه الداعم، ومعه شبيحة كثر يساندونه في طول العالم العربي وعرضه.
يبقى أن التحديات التي يواجهها الرجل لا تزال كبيرة في الداخل والخارج، وعليه تبعا لذلك أن يواجهها بكثير من الحنكة إلى جانب القوة دون إثارة معارك جانبية خاطئة، مثل معركته ضد مواقع التواصل الاجتماعي.
(الدستور)
على أن ذلك لم يلبث أن تغير منذ 4 سنوات تقريبا، تحديدا منذ 31 أيار/مايو 2010، ذلك التاريخ الذي شهد مجزرة الصهاينة بحق سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة نحو قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه.
كانت ردة فعل أردوغان على المجزرة التي استشهد خلالها 9 أتراك قوية جدا، ومنذ تلك اللحظة دخلت العلاقة مع الكيان الصهيوني مرحلة من التوتر، فيما سبقتها حادثة الاشتباك اللفظي مع رئيس الكيان الصهيوني (بيريز) في دافوس، وهي كانت علامة فارقة أيضا، لكنها، ومعها حادثة مرمرة كانت بمثابة إعلان دخول لأردوغان إلى المجال العربي من بابه العريض، وبالطبع في ظل خضوع الوضع العربي لما يعرف بمحور الاعتدال بقيادة مصرية سعودية.
نفتح قوسا هنا لنشير إلى أن ردة فعل أردوغان الشديدة على مجزرة السفينة مرمرة كانت نقطة الفراق بينه وبين رجل الدين الصوفي “فتح الله غولن” الذي يعيش في أمريكا منذ سنوات بعيدة، وتربطه علاقات جيدة بالمحافظين الجدد الذين يرتبطون بدورهم بعلاقة حميمة مع دولة الاحتلال، وكانت المرة الأولى التي يوجه فيها “غولن” المُقل في التصريح والظهور انتقادات لأردوغان، معتبرا أن ردة فعله على حادثة السفينة كانت أكبر من اللازم.
لم تكد هذه القضية تهدأ، حتى جاء الربيع العربي من خلال ثورة تونس، ثم مصر واليمن وليبيا، ومن ثم سوريا، وهنا وجد أردوغان أن سياسة “صفر مشاكل” قد اصطدمت بالجدار المسدود، وها هو يضطر إلى اتخاذ موقف سياسي مما يجري، فإما أن ينحاز إلى لغة المصالح والبزنس، وإما أن ينحاز إلى لغة المبادئ، لاسيما أن بعض الاختبارات كانت محرجة، فالعلاقة التجارية مع ليبيا كانت قوية، والاقتصادية والسياسية مع سوريا كانت أكثر قوة، ولعل ذلك هو ما دفعه إلى التردد بعض الشيء قبل أن يحسم الموقف لصالح المباديء، وينحاز بكل قوة، وبشكل كلّفه الكثير، ولا يزال، إلى جانب الشعب السوري، وقبل ذلك الشعب الليبي والمصري، ومن ثم إلى فكرة الربيع العربي برمتها.
هنا بدأ هجوم القوى السياسية اليسارية والقومية العربية يشتد عليه، وأصبح بنظرهم “السلطان العثماني الذي يسعىلاستعادة إرث أجداده”، فيما كان في بعض تجليات الخطاب عميلا للإمبريالية والصهيونية، لكن اللافت هنا أن الهجوم عليه لم يتوقف عند هؤلاء، بل امتد ليشمل أنظمة عربية تقليدية من تلك التي وقفت ضد ربيع العرب، وهذه تحديدا لم تكتف بالحملة الإعلامية، بل شارك بعضها في مؤامرات ضده على أكثر من صعيد، ووصل الحال حد التواصل مع قوى داخلية مثل الأكراد لأجل تحريضهم على نسف اتفاقهم التاريخي معه، فيما كان لسوريا وإيران تواصلها مع حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل العلويون كتلة كبيرة من جمهوره وأنصاره. وكانت العلامة الفارقة في تصعيد الحملة المناهضة لأردوغان هي وقفته ضد الانقلاب في مصر الذي حظي بدعم غير مسبوق من قبل أنظمة الثورة المضادة، ومن قبل قوى اليسار والقوميين أيضا، وكانت وقفة مشهودة خلت حتى من الحساب السيسي، هي التي كان يمكن أن تكون أكثر اعتدالا في ظل وضوح صمود الانقلاب بسبب خلل ميزان القوى الداخلي والخارجي لصالحه.
هذا الهجوم الشرس على أردوغان من قبل يساريين وقوميين، وتاليا من قبل أنظمة الثورة المضادة، ومن ثم ظهور المؤامرة الكبيرة عليه من قبل جماعة غولن، جعلت من الرجل محط أنظار الجماهير العربية، ودفعها نحو الانشغال بمعاركه، بل أصبحت خائفة عليه إلى حد كبير، لاسيما أن شعار إلحاقه بمرسي قد بدأ يتردد في الكثير من الأوساط العربية الرسيمة المناهضة للثورات وربيع العرب.
لكن ما ينبغي تذكره أيضا هو أن الحشد المذهبي في المنطقة، وشعور الغالبية السنيّة بالغطرسة الإيرانية قد أضاف اهتماما كبيرا بالشأن التركي، وحيث شعرت تلك الغالبية بإمكانية أن تشكل تركيا عنصر توازن مع إيران على مستوى الإقليم.
من هنا جاء الاهتمام الكبير بالانتخابات البلدية الأخيرة، بوصفها استفتاءً على الرجل، بخاصة بعد سلسلة تسريبات سعت بكل قوة إلى تشويهه وقادة حزبه واتهامهم بالفساد، ولذلك أيضا جاءت الفرحة الكبيرة التي عاشتها جماهير الأمة المنحازة للثورات بفوزه الكبير، فيما كانت الخيبة من نصيب كل تلك الفئات في مصر، وكذا أنظمة الثورة المضادة، إلى جانب نظام بشار وتحالفه الداعم، ومعه شبيحة كثر يساندونه في طول العالم العربي وعرضه.
يبقى أن التحديات التي يواجهها الرجل لا تزال كبيرة في الداخل والخارج، وعليه تبعا لذلك أن يواجهها بكثير من الحنكة إلى جانب القوة دون إثارة معارك جانبية خاطئة، مثل معركته ضد مواقع التواصل الاجتماعي.
(الدستور)