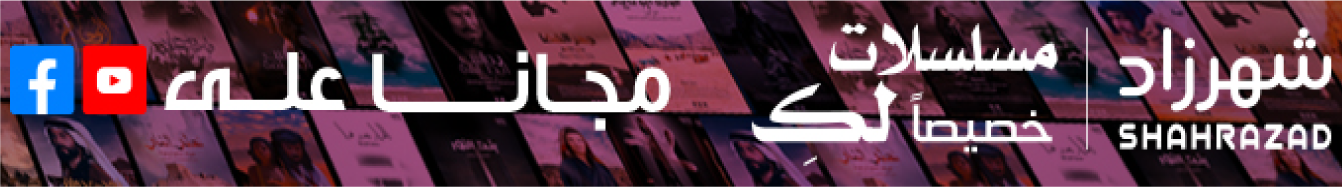النصيحة الثمينة لحماس!!

ياسر الزعاترة
جو 24 : قبل ما يقرب من عقدين، خرج علينا “خالد الذكر” شعبان عبد الرحيم أو “شعبولا” بأغنيته الشهيرة “بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل”، وكانت الأغنية -على تفاهتها- لحنًا وأداءً وكلماتٍ مما اشتهر في ذلك الحين في مدح وزير الخارجية المصري الذي سيغدو لاحقا أمين عام الجامعة العربية تبعا لخوف حسني مبارك من شعبيته.
والحال أن عمرو موسى لم يكن في حينه يعبر عن بطولة شخصية وهو يتحدث بلغة “متشددة” بمقياس الأنظمة حيال الكيان الصهيوني، فقد كان النظام المصري نفسه في ذلك الوقت دخل في تحالف ثلاثي لم يدم طويلا مع السعودية وسوريا في مواجهة موجة التطبيع التي تلت اتفاق أوسلو منتصف التسعينيات، وخشيت مصر من تمدد الصهاينة في طول الوطن العربي وعرضه ضمن سياق من تنظيرات شيمون بيريز عن الشرق الأوسط الجديد.
والنتيجة أن عمرو موسى لم يكن يصرِّح بموقف شخصي، فالمنصب الذي يتبوأه لا يسمح بشيء كهذا، وحين أصبح أمينا عاما للجامعة العربية ظل من الناحية العملية، كما سواه من الأمناء العامين المصريين، يعبر عن الموقف الرسمي المصري، ومن ورائه منظومة الاعتدال العربية، أو ما يعرف بمحور الاعتدال في ذلك الحين.
بعد ثورة يناير بحث عمرو موسى -ورغم بلوغه من العمر عتيا- عن موقع جديد، واعتقد أن بوسعه أن يكون رئيسا للبلاد، لكن المفاجأة كانت في فشله المدوي، فلجأ إلى تأسيس حزب، يحتاج الناس إلى العودة لـ”غوغل” لكي يتذكروا اسمه، وهو حزب الرجل الواحد أو “ون مان شو” كما يقال.
وحين بدأت الهجمة على مرسي، كان الرجل ضمن الجوقة، وحين جاء الإخوان يسترضونه، لم تكن النتيجة سوى رفع سعره في سوق السياسة يومها، إذ انهالت عليه “بركات” أنظمة الثورة المضادة، فما كان منه غير الدخول في تحالف معهم عرف بجبهة الإنقاذ، وشارك في المؤامرة التي أطاحت بالرئيس مرسي.
انتهت جبهة الإنقاذ، وجاء الحكام الجدد، وكانت مكافأته الأولية هي وضعه على رأس لجنة الدستور، ولكنها مكافأة عابرة، فيما عيْن الرجل على ما هو أكثر من ذلك، هو الذي يعلم أن الانتخابات القادمة لن تمنح حزبه العتيد شيئا مذكورا، هو الذي سيتشكل من نخب النظام القديم، وما سيجري تشكيله من نخب النظام الجديدة التي لن يكون هو من بينها على الأرجح، حتى لو حصل على مقعد في مجلس الشعب.
للحصول على موقع في النظام الجديد بعد رئاسة السيسي، ولأنه يدرك أن إرضاء الصهاينة هو المدخل لأي موقع جديد، فقد ذهب إلى واشنطن، ومن هناك أطلق دعوته إلى حركة حماس بضرورة “الاعتراف بإسرائيل”. وقال أمام الصحافيين بالنص: “”على حماس أن تعلن قبولها بمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تشكل خطة للتطبيع والاعتراف بدولة إسرائيل وكذلك قيام دولة إسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة”.
يعلم عمرو موسى، ولا حاجة لأن يذكّره أحد، أن المبادرة العربية لم تحظ بأية التفاتة ذات قيمة من الكيان الصهيوني، وها إن محمود عباس يقبل بما هو أقل منها بكثير، كما عكست وثائق التفاوض دون جدوى، ويعلم أن كل المفاوضات والاعترافات التي بادرت إليها حركة فتح، لم تجد نفعا، ولا تزال لاءات نتنياهو تملأ الأجواء، فلماذا يكون على حماس أن تقدم هذا التنازل المجاني للعدو، وهل الأخير بحاجة إليه. ألم يكن بوسعه أن يقدم التنازل للسلطة وقيادتها لو كانت لديه نية التنازل؟!
كل ذلك يعرفه تماما عمرو موسى، فهو ليس مستجدا في عالم السياسة، لكن ما أراده عمليا هو تقديم أوراق اعتماد للصهاينة، وللأمريكان على أمل أن يشكل ذلك محطة لموقع في النظام المصري الجديد الذي ينبغي أن يدفع هو الآخر من جيب قضايا الأمة، وبخاصة فلسطين لكي يرد جميل نتنياهو الذي عمل مقاول علاقات دولية لحسابه، وضغط على أميركا ودول كثيرة من أجل الاعتراف بالانقلاب.
الأرجح أن الرجل الذي يقترب حثيثا من الثمانين لا زال يطمح برئاسة الوزراء في النظام الجديد، ولكن إذا لم يكن ذلك متاحا، فلتكن وزارة الخارجية أو منصبا آخر، المهم هو ألا يخرج من مشهد الانقلاب خالي الوفاض. فهل ينجح مسعاه؟ ليست لدينا إجابة، لكنه كسب شرف المحاولة على كل حال!!
(الدستور)
والحال أن عمرو موسى لم يكن في حينه يعبر عن بطولة شخصية وهو يتحدث بلغة “متشددة” بمقياس الأنظمة حيال الكيان الصهيوني، فقد كان النظام المصري نفسه في ذلك الوقت دخل في تحالف ثلاثي لم يدم طويلا مع السعودية وسوريا في مواجهة موجة التطبيع التي تلت اتفاق أوسلو منتصف التسعينيات، وخشيت مصر من تمدد الصهاينة في طول الوطن العربي وعرضه ضمن سياق من تنظيرات شيمون بيريز عن الشرق الأوسط الجديد.
والنتيجة أن عمرو موسى لم يكن يصرِّح بموقف شخصي، فالمنصب الذي يتبوأه لا يسمح بشيء كهذا، وحين أصبح أمينا عاما للجامعة العربية ظل من الناحية العملية، كما سواه من الأمناء العامين المصريين، يعبر عن الموقف الرسمي المصري، ومن ورائه منظومة الاعتدال العربية، أو ما يعرف بمحور الاعتدال في ذلك الحين.
بعد ثورة يناير بحث عمرو موسى -ورغم بلوغه من العمر عتيا- عن موقع جديد، واعتقد أن بوسعه أن يكون رئيسا للبلاد، لكن المفاجأة كانت في فشله المدوي، فلجأ إلى تأسيس حزب، يحتاج الناس إلى العودة لـ”غوغل” لكي يتذكروا اسمه، وهو حزب الرجل الواحد أو “ون مان شو” كما يقال.
وحين بدأت الهجمة على مرسي، كان الرجل ضمن الجوقة، وحين جاء الإخوان يسترضونه، لم تكن النتيجة سوى رفع سعره في سوق السياسة يومها، إذ انهالت عليه “بركات” أنظمة الثورة المضادة، فما كان منه غير الدخول في تحالف معهم عرف بجبهة الإنقاذ، وشارك في المؤامرة التي أطاحت بالرئيس مرسي.
انتهت جبهة الإنقاذ، وجاء الحكام الجدد، وكانت مكافأته الأولية هي وضعه على رأس لجنة الدستور، ولكنها مكافأة عابرة، فيما عيْن الرجل على ما هو أكثر من ذلك، هو الذي يعلم أن الانتخابات القادمة لن تمنح حزبه العتيد شيئا مذكورا، هو الذي سيتشكل من نخب النظام القديم، وما سيجري تشكيله من نخب النظام الجديدة التي لن يكون هو من بينها على الأرجح، حتى لو حصل على مقعد في مجلس الشعب.
للحصول على موقع في النظام الجديد بعد رئاسة السيسي، ولأنه يدرك أن إرضاء الصهاينة هو المدخل لأي موقع جديد، فقد ذهب إلى واشنطن، ومن هناك أطلق دعوته إلى حركة حماس بضرورة “الاعتراف بإسرائيل”. وقال أمام الصحافيين بالنص: “”على حماس أن تعلن قبولها بمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تشكل خطة للتطبيع والاعتراف بدولة إسرائيل وكذلك قيام دولة إسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة”.
يعلم عمرو موسى، ولا حاجة لأن يذكّره أحد، أن المبادرة العربية لم تحظ بأية التفاتة ذات قيمة من الكيان الصهيوني، وها إن محمود عباس يقبل بما هو أقل منها بكثير، كما عكست وثائق التفاوض دون جدوى، ويعلم أن كل المفاوضات والاعترافات التي بادرت إليها حركة فتح، لم تجد نفعا، ولا تزال لاءات نتنياهو تملأ الأجواء، فلماذا يكون على حماس أن تقدم هذا التنازل المجاني للعدو، وهل الأخير بحاجة إليه. ألم يكن بوسعه أن يقدم التنازل للسلطة وقيادتها لو كانت لديه نية التنازل؟!
كل ذلك يعرفه تماما عمرو موسى، فهو ليس مستجدا في عالم السياسة، لكن ما أراده عمليا هو تقديم أوراق اعتماد للصهاينة، وللأمريكان على أمل أن يشكل ذلك محطة لموقع في النظام المصري الجديد الذي ينبغي أن يدفع هو الآخر من جيب قضايا الأمة، وبخاصة فلسطين لكي يرد جميل نتنياهو الذي عمل مقاول علاقات دولية لحسابه، وضغط على أميركا ودول كثيرة من أجل الاعتراف بالانقلاب.
الأرجح أن الرجل الذي يقترب حثيثا من الثمانين لا زال يطمح برئاسة الوزراء في النظام الجديد، ولكن إذا لم يكن ذلك متاحا، فلتكن وزارة الخارجية أو منصبا آخر، المهم هو ألا يخرج من مشهد الانقلاب خالي الوفاض. فهل ينجح مسعاه؟ ليست لدينا إجابة، لكنه كسب شرف المحاولة على كل حال!!
(الدستور)