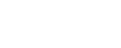نحو سياسـة وطنيـة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

لقد امتدت الحضارة اليونانية والتي أحدثت تقدماً ملموساً في العلوم في الفترة الواقعة بين (450 - 600BC )، ثم جاءت المساهمة الصينية في العلوم في الفترة الواقعة بين (600 – 700 AD) حتى ازدهرت العلوم العربية في العصر الذهبي للعرب بين (750 – 1100 AD) ثم تلتها الحضارة الأوروبية منذ 1350 وحتى الآن.
لقد تصدر العرب الحضارة والعلوم والفلسفة في القرنين السابع وحتى الرابع عشر حين كانوا رواداً في الرياضيات والفيزياء والفلك والطب. في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت معظم الدول العربية تحت الاستعمار الأوروبي ورغم أن الاستعمار الأوروبي كان أول من أدخل التعليم الإلزامي الا أن التعليم الحديث كان مقتصراً على أقليات معينة. والهدف من هذه السياسة السيطرة على العقلية الذكية ومنعها من التطور ومواجهة السيطرة السياسية للاستعمار. التعليم كان غير كافٍ والصفوف مكتظة والمدرسين غير مدربين بشكل مهني والنتيجة كانت أن من يصل التعليم العالي تنقصه المعلومة والمهارة المطلوبة للدراسات الأكاديمية.
المؤسسات التي ورثتها الدول العربية بعد حقبة الاستعمار كانت متنوعة بين الحديثة والإسلامية والعامة والخاصة وكانت لغة التدريس الرئيسة العربية وأحياناً العربية والانجليزية. ولم تكن فرصة السفر للخارج لمتابعة الدراسة مفتوحة سوى للأغنياء أو البعثات الحكومية.
بعد زوال الاستعمار وإنشاء إسرائيل في المنطقة وازدهار صناعة النفط أصبحت المنطقة ملتهبة سياسياً وأصبحت الدول العربية – ومن ضمنها الأردن- تركز على التسلح حتى اختل ميزان الأولويات وطغى الصرف على التسلح على التعليم والصحة مما قلل وبشكل ملحوظ من مستوى التعليم والبحث العلمي والتطوير.
الاقتصاد المبني على المعرفة
لقد حمل القرن الواحد والعشرين تحديات مؤثرة على العالم العربي كباقي الدول النامية. حيث ازداد التنافس الدولي الناجم عن مختلف ظواهر العولمة، كما أصبح من الواضح أن الاقتصاد القوي هو الاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge-based Economy.
إن تغير مصادر وطرق تطوير المنتجات الجديدة القائمة على المعرفة غيٌر الفكر والسلوك الإنساني وجعلت من المُلٌح زيادة تأهيل وتدريب الكوادر المعنية بشكل يتناسب مع التحدي الجديد حتى أصبحت بعض عناصر النجاح التقليدية التي كانت سائدة في الدول النامية، كرخص اليد العاملة ورخص الأراضي عاملاً ثانوياً لا يمكن الاعتماد عليه لبناء اقتصاد حديث ومستدام حتى أصبح البحث العلمي والتطور التكنولوجي المحليين هما وسيلة أساسية لبناء مجتمع المعرفة القادر على مواجهة التحديات المختلفة.
النمو الاقتصادي والنمو التكنولوجي
إن ضعف المستوى التكنولوجي وضعف نموه هما من أهم قضايا الاقتصادات العربية التي أدت على مر العقود الأخيرة إلى ازدياد نسبة البطالة وانخفاض معدلات النمو، وهجرة العقول والرساميل وزيادة المديونية. وهذا كله يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وعدم القدرة على التنمية الاجتماعية والإنسانية في الدول العربية.
التكنولوجيا هي ما يُمكٌن الإنسان من نقل فكرة علمية إلى منتج مفيد وهذا المنتج يشمل السلع والمواد والعمليات والخدمات. في السابق كانت معادلة النمو الاقتصادي تقول ببساطة أن النمو يتناسب طردياً مع الأيدي العاملة وراس المال وقد حصل "سولو" على جائزة نوبل في الثمانيات من القرن العشرين على تقنينه لهذه النظرية بإدخال عامل التكنولوجيا بشكل غير مباشر في كل من رأس المال والعمالة، أي أنها تعتبر المستوى التكنولوجي وراس المال عاملي إنتاج مباشرين حيث يتضمن رأس المال الفيزيائي المتمثل بوسائل الإنتاج والتكنولوجيات المجسدة في المواد المستعملة وفي الإدارة وغيرها وراس المال البشري الذي يتمتع بمعرفة وخبرة أو ممارسة تكنولوجية. كما تضمن رأس المال الاجتماعي على عمل جماعي في تشكيل منظومة العلم والتكنولوجيا وفي الشعور بالمسؤولية الجماعية وفي الأمانة والإخلاص في العمل.
لقد أصبح جلياً أن معدل النمو الاقتصادي يعتمد على معدل النمو التكنولوجي فإذا أردنا زيادة معدل النمو الاقتصادي في الأردن فعلينا من جهة تحسين المستوى التكنولوجي وزيادة معدل نموه السنوي ومن جهة أخرى زيادة نسبة الادخار واستثمار الرساميل المدخرة عملياً في اتجاهات تكنولوجية. وهذا يؤدي إلى زيادة فرص العمل وبالتالي فان الاقتصاديات التي تحمل مستوى تكنولوجياً عالياً ونمواً تكنولوجياً عالياً تجذب رؤوس الأموال وتجذب المستثمرين والعكس صحيح. وهذا يفسر هجرة العقول العربية اذا أن أكثر من 230 ألف عربي هاجروا من الوطن العربي خلال ثلاثة عقود ويفسر كذلك هجرة رأس المال العربي إذ بلغ أكثر من 1300 مليون دولار حسب بعض التقديرات، ولا شك أن النمو الاقتصادي من أهم مشاكل الأردن. إذ يؤدي عدم ازدياده الحقيقي والمطرد إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والى البطالة وهجرة العقول وهجرة رأس المال المدخر وانخفاض الدخل وعدم التنوع الاقتصادي والى المديونية المتراكمة، ومن هنا تكتسب عملية نقل التكنولوجيا إلى الأردن أهمية بالغة وعليه فان البحث في موضوع إدارة التكنولوجيا يتعلق بتعدد الجوانب المتصلة بتملك واكتساب التكنولوجيا. إذ إن اكتساب التكنولوجيا يشمل نقل التكنولوجيا ثم توطينها بهدف توليدها.
إدارة التكنولوجيا
لقد انحصر مفهوم نقل التكنولوجيا في الأردن في نقل مصنع يقدم منتجاً أو عدة منتجات والتمكن من تشغيله وفق عقد ترخيص يحدد عدداً من الممارسات المتعلقة بتعديل عملية الإنتاج والمواد المستعملة ومصادرها.
أما توطين التكنولوجيا فهي مرحلة أكثر تقدماً – ربما لم نصل لها بعد – وهي مرحلة يكون فيها فهم أعمق للتكنولوجيا المنقولة بحيث يمكن تطويرها وتحسينها لتعديل مواصفات المنتج ليظل منافساً ويمكن أن يتضمن هذا طريقة الإنتاج والمواد الداخلة في الإنتاج.
أما توليد التكنولوجيا فهي المحطة الأمل وتكون بإيجاد تكنولوجيات جديدة مبتكرة أو متطورة محلياً يمكن بواسطتها تصنيع منتجات مستحدثه ومنافسة عالمياً.
وتشمل إدارة نقل التكنولوجيا اختيار المنتج واقتنائه واستخدام التكنولوجيا، أما إدارة توطين التكنولوجيا فتضمن الهندسة العكسية والتطويع التكنولوجي وفك الحزمة التكنولوجية وملائمته مع البيئة، أما إدارة توليد التكنولوجيا فترتكز على البحث والتطوير وإدارة النظام الوطني للابتكار National Innovation System وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وتوليد مصانع أو شركات جديدة وتمويل التكنولوجيا.
لقد عانت اقتصاديات الدول العربية من نقص فادح في المستوى التكنولوجي وفي معدل نمو هذا المستوى وحسب دراسة للبنك الدولي فإن التأثير التراكمي لنقل التكنولوجيا ونموها في الوطن العربي بين 1960 – 1992 قد أنتج معدل نمو سالب أي أن زيادة الإنتاجية العربية سالبة أي بعبارة أخرى إن الزيادة في الاستثمار والزيادة في عدد العاملين أديا إلى زيادة أقل مما يجب في الناتج الإجمالي المحلي.
وعليه وحتى ينجح الأردن في عملية إدارة التكنولوجيا فلا بد من:
1. صياغــــة سياســة وطنيــة للعلـم والتكنولوجيـا National Policy for Science & Technology تحدد بموجبها أولويات البحث والتطوير والابتكار (إذ أن بحث وتطوير دون ابتكار يعتبر ناقصاّ) ومن المجالات التي يجب أن تتصدى لها المنظومة؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا النانووية وعلم المواد.
2. إقامة هيكلة ناظمة لإدارة أنشطة البحث والتطوير والابتكار تبدأ من أعلى مستوى في الأردن وتنتهي بالمختبرات البحثية. مروراً بمستشارين فهيئة عليا وصولاً إلى وزارة أو وزير دولة ثم إلى مختلف المؤسسات البحثية والإنتاجية والممولة والتي تشكل المنظومة الوطنية للابتكار. على أن تحكم العلاقة بينهم سياسة عامة ثابتة لا تتغير كلياً كل سنة أو كل بضع سنوات. وتتطلب هذه الهياكل التنظيمية منهجيات علمية مثل إدارة التكنولوجيا وإدارة المعرفة Management of Knowledge & Technology Management.
3. لا بد من تمويل الرعاية والإبداع والتجديد بطرق مختلفة غير طرق التمويل التقليدية القائمة على القروض الصغيرة، وإنما رأس مال مخاطر أو مبادر Venture Capital.
4. لا بد من وضع تشريعات وقوانين مناسبة ( أو تطوير القائم منها) تتضمن الملكية الفكرية وعدم الاحتكار مع وجود بيئة مال داعمة تتضمن حاضنات وحدائق التكنولوجيا ومراكز المعلومات والابتكار.
5. لا بد من تدخل الدولة لإدارة ونشر المعرفة والتكنولوجيا بل من الأفضل أن يترأس جلالة الملك مجلساً أعلى للبحث والابتكار حتى يأخذ الموضوع اهتماماً وزخماً وطنياً.
6. الإنفاق المستمر على البحث والتطوير إذ بلغ الإنفاق في الأردن على البحث العلمي ما لا يزيد عن 0.34% من الدخل العام وهو رقم متواضع وإن زاد عن معدل الدول العربية والبالغ 0.2% في حين بلغت إسرائيل 4.8%، واليابان 3.4%، وأمريكا 2.7%، وألمانيا 2.5%.
7. كذلك فمن المهم أيضاً اعادة صياغة آليات دعم البحث العلمي إذ أن المصدر الأساسي في الأردن يأتي من الحكومة وهذا حال جميع الدول العربية الأخرى إذ تقدم الحكومة ما مجموعه 78% من الدعم في مقابل 12% من قطاع الصناعة و 8% من جهات خارجية و 1% وقف وتبرعات في حين نرى أن 67% من الدعم في اليابان يأتي من قطاع الصناعة و 22% فقط من الحكومة وفي بريطانيا 54% من قطاع الصناعة و 30% من الحكومة.
8. بات من المهم تعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية إلى جانب اللغات الأخرى في التعليم العالي إذ أن الابتكار يتطلب لغة يفهمها الفني الصغير وحامل الدكتوراة ليتكامل المشروع.
وتبرز أحياناً جدلية البحث والتطوير والابتكار والاستيراد للمعرفة والتي تتضمن أن الاستيراد يشكل بديلاً سهلاً وسريعاً عن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للارتقاء بما هو موجود، وأن الاستيراد يمثل المدخل الأسهل للإدارات الحكومية لحل مشكلاتها أمام المستهلك الا أن الاستيراد شأنه تخفيض فرص الإبداع والابتكار في تطوير الحلول الجديدة ويبقي الأمور على ما هي من التخلف والضعف والتراجع.
أولويات البحث العلمي
إن الأولويات الأردنية معروفة وهي الطاقة التي نستورد 96% من حاجتنا من الخارج، والماء ونحن نعد من أفقر أربع دول في العالم، أما ما قامت به وزارة التعليم العالي بإصدار كتاب الأولويات فإن ما تم نشره جاء عاماً ولا يخدم الحاجة الوطنية بشكل مباشر ثم جاء صندوق دعم البحث العلمي ليضيع 12 مليون دينار عبر السنوات الماضية والتي كان يجب أن تتركز في مشروع واحد مثل تحلية المياه أو معالجة المياه العادمة كما هو الحال في مشروع الخضيرة في إسرائيل، أو إنتاج غاز الميثان من القمامة أو كما أنتجت البرازيل غاز الإيثان كوقود للسيارات من قصب السكر (إذ أنها تنتج 1/3 إنتاج العالم) إذ طورت زراعة قصب السكر خلال ثلاثين عام مضت لهذه الغاية.
على الباحثين الأردنيين البحث في حاجات الأردن الأساسية وعدم البحث في مجالات تهم أمريكا وأوروبا بل على العلماء والباحثين الأردنيين أن يكونوا جزءً من الحكومة حتى يستقيم القرار السياسي في مصب العلم والمعرفة.
دور الجامعات
إن السؤال الأكثر أهمية هو من يدير عجلة التكنولوجيا والابتكار؟ يعتقد البعض أن الجامعات هي المحرك الأساسي للبحث والتكنولوجيا والأساس هو قرار سياسي ومظلة حكومية تحرك القطاع الخاص ومن ثم الجامعات التي بمقدورها الإشارة للتكنولوجيا الحديثة وتقديم العقول العاملة بالبحث العلمي.
لقد تدهور البحث العلمي حتى باتت إنتاجية الباحث الأردني لا تزيد عن0.85% وهي أفضل من إنتاجية العلماء العرب إذ يبلغ متوسط بحوثهم 0.4% سنوياً أي بحث واحد في كل عامين ونصف من حياة العالم العلمية في الجامعات، إلا أن الرقم الأردني لا يعكس أي تقدم خاصة وان البحث غير مرتبط بالحاجة الوطنية وفي الجامعات وما هو الا لأغراض الترقية وإن كانت بعض الأبحاث جيدة فمن يقرأها من الحكومة التنفيذية بل ربما الأسهل التعميم على أن جميعها أبحاث ذات مستوى متدن„.
فالمطلوب من الجامعات في ظل غياب منظومة علم ومعرفة حكومية أن تتبنى إنشاء Spin – off Companies.
في حين يتحدث الأكاديميون عن ضغط التدريس وعدم وجود فسحة من الوقت للبحث العلمي إذ بلغ عدد الطلبة في الجامعات الأردنية (244245) طالب مع وجود (8149) عضو هيئة تدريسية فقط وبنقص (2047) عضو هيئة تدريسية لتصبح نسبة مدرس لطالب تتجاوز 30:1 ولكن السؤال لماذا فشلت مراكز البحث العلمي في الجامعات ولماذا ما زالت تعمل على شكل One man واعتقد أن الحل هو إنشاء مجموعات بحثية بل وتعيين باحثين من خلال Spin – off Companies .
معادلة البطالة وهجرة الأدمغة
المدهش أن عدد سكان الشرق الوسط وشمال أفريقيا يصل حوالي 400 مليون ومقدر له أن يصل ل 700 مليون عام 2050 ويوجد 229 جامعة حالياً ويقدر أن يصل العدد ل 400 جامعة وعدد الطلبة حوالي 4 مليون ويقدر أن يصل ل 8 مليون وعدد أعضاء الهيئة التدريسية 187000 ويقدر أن تكون الحاجة ماسة لحوالي330000 من حملة شهادة الدكتوراة وكون الأردن جزء من هذه الإحصائيات والمتوقع أن يصل عدد سكانه ل 10 مليون عام 2050 (وخاصة إذا علمنا أن 5 مليون أردني هم في عمر 40 عاماً أو اقل) فلا بد من العمل بجد لإدارة التكنولوجيا للحد من البطالة إذ بلغت البطالة العامة في الأردن ل 13% وتقدر بين حملة البكالوريوس ب 27% ، أما حملة البكالوريوس وأعلى فهي تقدر ب 44%.
تقدر قوة العمل الأردنية المهاجرة ب 670000 إلا أن 40% منها من المتخصصين والفنيين في حين بلغت قوة العمل الإدارية 22% والخدمات 32% وتزيد نسبة الجامعيين من القوة العاملة عن 35%. إن هجرة الأدمغة الأردنية لهي تحد كبير ورغم عدم توفر أرقام دقيقة عن الأردن إلا أن الأرقام العربية تمثل الأردن نوعاً ما وتشير بأن هجرة العلماء العرب تمثل 35% من الهجرة العامة. إن الدول العربية تخسر 50% من الأطباء الجدد و 23% من المهندسين و 25% من المتخصصين في العلوم البحتة. إن 75% منهم يذهبون لدول كبريطانيا وأمريكا وكندا. وهذا يشكل خسارة 2 بليون دولار سنوياً. والأكثر خطورة أن 45% من الطلبة العرب لا يعودون لبلادهم وهذه ظاهرة متنامية في الأردن وكلنا نعلم أن غياب العلماء يعني غياب المعرفة وتقدم الدول وهذا يهدد مستقبل الأردن والدول العربية الأخرى وإن كان أكثر أسباب الهجرة للأردنيين مالية إلا أن الأسباب العامة للهجرة تكاد لا تخرج عن أسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وشخصية.
إن المطلوب من الدول العربية إيجاد 2 مليون وظيفة سنوياً بين 2010 – 2020 وهذا شبه مستحيل لعدم وجود استراتيجية اقتصادية وغياب الاستثمار الأمين وانتشار الفساد المالي والإداري وتدني مستوى التعليم.
والسؤال كيف تستمر معدلات البطالة رغم تقرير التعليم الأساسي وتراجع الأمية وانتشار التعليم الجامعي؟ إذ كما أسلفت بلغ عدد طلبة الجامعات في الأردن حوالي 250.000 وفي الوطن العربي حوالي 6 مليون وحينما نعلم أن عدد خريجي الوطن العربي فاق عدد سكان كوريا الجنوبية فان السؤال الأكثر دهشة كيف يستطيع بلد كالهند أو الصين أن تكون لديها نسبة بطالة منخفضة تقترب من 6% في الهند و 4.5% في الصين، يكون الجواب ببساطة أنه مجتمع المعرفة.
الإدارة والانتماء
أما المعطل الرئيس في وصول الأردن لمستوى دول العالم الثاني هو ضعف الإدارة العامة فالاستراتيجيات غير موجودة أو غير مطبقة وإن وجدت لا يوجد من يحاسب فيما لو نفذت أم لا. أكاد أجزم أن لا مؤسسة أردنية لديها نظام تدقيق إداري داخلي. بل أسوأ ما أراه أحياناً أننا نتخذ قرارات دون تخطيط ولا نهتم بالتفاصيل الدقيقة كما حدث في مشروع الباص السريع ولا نقرأ تجارب الآخرين فكم كانت تجارب ماليزيا وسنغافورة والنرويج والبرازيل وايرلندا مفيدة لو درست واستخلصت منها العبر. أتمنى أن نغلق ملف واحد من مشاكلنا وأن نفرز مفهوم العمل الجماعي وروح الفريق والابتعاد عن خيار الصفر وهو ما تكسبه أنت خسارة لي.
أن سبب ضعف الإدارة الأساسي هو عدم وضع الرجل الأفضل في المكان الناسب فالجيدون كُثر أما المبدعون فهم قلة “حتى أن الإداري في الأردن هو في الغالب أحد المحظوظين وليس احد الأكفاء المستحقين للرعاية فهو الشخص الذي يمهد له مستقبل دراسي„ راق„ في سلك التعليم الجامعي وهو في كثير من الأحيان قد يأخذ هذا المكان من أخر أكثر استحقاقاً وكفاءة سواء بالواسطة أو القربة، أو غير ذلك، وهذا الشخص لا يمكن أن يبتكر شيئاً، والذي يمكنه الابتكار والبحث المجدي طرد من مكانه الحقيقي إلى خارج السلك البحثي ووضع مكانه من لا يستحق” وهنا يغيب الانتماء المكتسب المبني على تساوي الحقوق والفرص إذ إن الانتماء الفطري المبني على الأصول والمنابت لم يعد مجدياً.
تتوفر في الأردن بيئة تحتية جيدة وشباب أردني قادر على التعلم والتدرب إلا أن غياب المنافسة يسبب عجزاً في تطور مؤسساتنا إذ أن دراسة للبنك الدولي تشير إلى أن نسبة سهولة التعيين في الأردن تفوق سهولة الاستغناء عن العاملين مما يمثل وجود الذكي والغبي والمجد والكسول سيان في نفس المجال!!!
جدلية التعليم والبحث
جدلية التعليم والبحث، جدلية تحتاج لوقفة، إذ أن ما يصرفه الأردن على التعليم يصل إلى 6.4 % من الدخل القومي وهذا يفوق المعدل العربي ومعدل الدول الصناعية ولكن وإن عكس هذا تفوق الأردن على الدول العربية خاصة في معايير تقييم مستوى التعليم إلا أن التعليم والذي يعتبر الخطوة الأساسية للبحث العلمي ما زال غير قادر على المنافسة عالمياً، فدولة صغيرة مثل سنغافورة تحقق أعلى المستويات العالمية في الرياضيات والعلوم. وهنا لا بد من أن نتعلم منهم وهو أنه يجب التركيز على تدريس العلوم البحتة في الجامعات وزيادة تشجيع الطلبة على دراسة الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء فهي أساس العلوم وسبيل تقدمهم. يدرس في العلوم الأساسية في الجامعات الأردنية 35% من طلبتها فيما يدرس في إيران 60% وفي تركيا وكوريا حوالي 45% وفي إسرائيل حوالي 40% وهذا يتطلب ضرورة زيادة ذلك لأنهم مفتاح العلم والمعرفة لا أن يسمح لطالب التوجيهي أن يسقط الكيمياء إذا أراد!!!.
خاتمة:
في الخلاصة لا بد من الإشارة إلى أن توطين التكنولوجيا هو قرار سياسي فالمطلوب التوقف عن إعلان التوصيات في المؤتمرات والعمل على معالجة الموضوع كقضية وطنية واستحداث سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فالاقتصاد القوي هو الاقتصاد المبني على المعرفة.
فبالنظر للأرقام الواردة من البنك الدولي حول دول اقتصاد المعرفة فإن السويد وايرلندا وكوريا وماليزيا وحتى تشيلي تتفوق على جميع الدول العربية والأردن كذلك إذ جاءت الأردن بعد البحرين والإمارات والكويت وقطر والسعودية أي دول الخليج العربي والتي بسبب الوفرة المالية واستقطاب الخبرات الأجنبية استطاعت أن تكون حكومات داعمة للاقتصاد والابتكار والتعلم والبنية التحتية إلا أن الابتكار يتطلب سواعد وطنية مبدعة. إن الصين التي أغرقت العالم بضاعتها تتطلع لتطوير إبداع علمائها للانتقال من مرحلة صنع في الصين لمرحلة صنعه الصينيون. علينا بالعمل الجاد والمنظم للوصول لمرحلة صنع في الأردن أو صنعه الأردنيون لتقليل نسب البطالة والفقر.
مراجع
1. The Road Not Traveled, MENA Development Report –the world bank.
2. ضمان جودة البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا بين الواقع والتطبيق في الوطن العربي: د. وفيق الآغا ود. رامز بدير 2010.
3. عكس التيار: أزمة الفقر والبطالة. د.إبراهيم بدران.
4. قضايا هامة وآليات تنفيذية للنقل الداخلي للتكنولوجيا ولتوطينها في الوطن العربي. محمد مراياتي: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) البحث العلمي وإدارة التكنولوجيا. سامر رفاعي، الأمين العام للمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.