هل تراجع أوباما؟..أبعاد الصراع
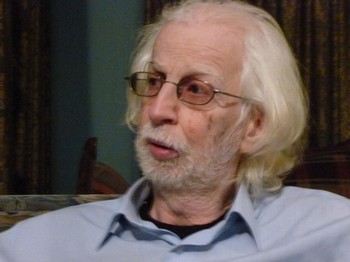
سلامة كيلة
جو 24 : القرار الأمريكي بتوجيه ضربة للنظام السوري وُضع في سياقات مختلفة، متفائلة «كما لدى أطراف في المعارضة» ومتشائمة «كما وضع السلطة وكل الممانعين». وبعضهم اعتبر أن أمريكا تكرر تجربة العراق في سوريا «وربما أكثر من ليبيا حيث تدخلت بطائراتها الحربية وصواريخها فقط». كل هؤلاء انطلقوا من أن المسألة هي أكبر من «ضربة صواريخ»، وأن أمريكا عادت لسياستها العسكرية بعد ما جرى لها في العراق.
الممانعون أكدوا روايتهم التي حفظوها عن ظهر قلب، وعجزوا عن نسيانها رغم تحولات الزمن. فقد أكدوا «المؤامرة الإمبريالية» على «سوريا الأسد». فرحوا كثيراً بأن هلوساتهم صحيحة، وأن الإمبريالية الأمريكية ما زالت تعمل على فرض الفوضى الخلاقة و«الشرق الأوسط الموسّع»، وعلى التقسيم والتفتيت الطائفي، وسايكس بيكو رقم 2. باختصار طاشوا، لكن سلطتهم كانت ترتعب من الخوف، فقد واجهت ما جاهدت منذ بدء الثورة لتلافيه: التدخل الإمبريالي، ليس حماية للوطن، بل خوفاً على السلطة ذاتها. فهي تعرف بأن دخول أمريكا على خط المواجهة يعني نهايتها بالحتم، لهذا ساومت روسيا منذ بدء الثورة على أن تعطيها ما تريد مقابل حمايتها دولياً، وفي مجلس الأمن خصوصاً. لهذا عقدت اتفاقات اقتصادية معها ترهن سوريا لروسيا ككل الاتفاقات الإمبريالية. وبتوقيع «الماركسي المرّ» قدري جميل.
وحين اطمأنت للحماية الروسية، ولعدم رغبة أمريكا في الدخول على خط الصراع، قررت تطوير العنف والانتقال إلى مرحلة التدمير الشامل والقتل الشامل. خصوصاً وهي تلاقي الهزائم على الأرض نتيجة تصاعد قوة الثورة، وزيادة دور العمل المسلح.
لكن فجأة ظهر بأن أمريكا مصممة على توجيه ضربة عسكرية بعد أن أخطأت السلطة الحساب واستخدمت السلاح الكيماوي في لحظة كانت تبدو قاسية على أمريكا. لهذا هرعت إلى موسكو من أجل إيجاد حل، خصوصاً بعد أن أعلن الروس بأنهم لن يشاركوا في الحرب دفاعاً عن السلطة السورية، وقاموا بوقف صفقات أسلحة متطورة، وسحبوا قطعهم البحرية من ميناء طرطوس.
حصلت أمريكا على تنازل عن كل الأسلحة الكيماوية. وإذا كان مبكراً التأكيد على جدية التنفيذ فإن مجرد الإقرار بالتسليم هو تأكيد على أن السلطة هي التي استخدمت هذا السلاح في الغوطة «حتى دون أن تشير وهي تقرر تسليمه إلى الجيش الحر الذي ادعت أنه هو من استخدم الكيماوي». وأيضاً لا شك في أن سهولة التسليم بهذا الحل تشير إلى أنها تعبر أن السلطة أهم من «التوازن الاستراتيجي» مع الدولة الصهيونية، ومن الأمن القومي.
بالتالي «المؤامرة» اكتملت حسب منطق كل الممانعين «لفظاً». وباتت الضربة حتمية، ولهذا فقد بدأت «المعركة القومية» ضد الإمبريالية. وبدأ الحديث عن «الرد الصاعق» من قبل حزب الله وإيران، ومن السلطة ذاتها التي ضربتها الطائرات الصهيونية مرات كثيرة وما زالت تبحث عن «الوقت المناسب» للرد.
إذن، بات أمر «الغزو» محسوماً، ومعه بدأت الركب في الاصطقاق، لكن في سيمفونية «قومية»، «نضالية» كثيرة الضجيج.
في المقابل، طارت المعارضة الخارجية «وبعض الداخلية» فرحاً، حيث تحقق «الحلم الطويل» الذي رافقها منذ بدء الثورة. فقد نادت بالتدخل العسكري طويلاً «وهي في ذلك كانت تضرّ الثورة كثيراً»، ورهنت انتصارها بدور القوى الإمبريالية وليس بقدرة الشعب، فقد كان العجز مرضها العضال، وكانت ثقتها بالشعب هي ما دون الصفر. لهذا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الأسد، والسعي لتسلم السلطة. وأصبح السؤال الذي يطرح في صفوف المعارضة هو هل نستطيع بناء سلطة بديلة، وإذا انهارت السلطة هل نحن قادرون على إقامة سلطة جديدة؟
لقد ارتفعت المعنويات إلى السماء، وبات إسقاط النظام قاب قوسين أو أدنى كما يقال. أخيراً «عادت أمريكا إلى رشدها»، هذا هو مكنون كل هؤلاء العجزة الذين ظلوا ينتظرون من يأتي بهم إلى السلطة «ولو على الدبابة الأمريكية».
في كل ذلك ظهر أن الأمر بات محسوماً، وأن الضربة حتمية حتى بعد تصويت مجلس العموم البريطاني ضد مشاركة بريطانيا في الحرب. ورغم «تنكيشات» الكونجرس، والجو الشعبي العام في أوروبا وأمريكا ضد الحرب. ولقد انقسم «العالم» مع الضربة أو ضدها. وأصبح هذا هو مقياس تصنيف، وأساس تحديد الوطنية أو الحرية.
لكن فجأة توقف كل شيء. فقد رمى جون كيري «فكرة عابرة» التقطها سيرغي لافروف وباتت مبادرة روسية، جوهرها فرض الرقابة على الأسلحة الكيماوية في سوريا، والعمل على تدميرها، ومن ثم انضمام سوريا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية. وافق وليد المعلم الذي هرع إلى موسكو بعد «العين الحمرا» الأمريكية، وجرى اعتبار الخطوة حدثاً مهماً جعل أوباما يطلب تأجيل اتخاذ قرار في مجلس الشيوخ بتفويضه بالضربة العسكرية. أوروبا تحمست، وأمريكا بدت مهتمة، و«تغلب الحل الديبلوماسي» على الحرب. الممانعون هللوا لـ «النصر»، حيث أفشلت الخطة الأمريكية لـ «تدمير سوريا» (وكأن هناك ما بقي لكي تدمره الإمبريالية)، ولإسقاط النظام. بتجاهل مفرط لتنازل السلطة عن «سلاح ردع» في مواجهة الدولة الصهيونية، وبتنفس الصعداء لأن السلطة لم تسقط نتيجة الضربة المحتملة كما كان يسكن قعر وعيهم.
والمعارضة التي تفاءلت كثيراً أصيبت بصدمة قوية، حيث أصبح حلمها سراباً. ساد اليأس، وانكشفت كقوى تنادي باحتلال بلدها.
المشكلة تمثلت في أن كل هذا «الجو» كان نتاج تحليل مفرط في الخطأ، ينطلق من رؤية أمريكا وكأنها أمريكا العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين. أمريكا التي تريد السيطرة على العالم بقوتها العسكرية وتفوقها التكنولوجي. بينما كانت أمريكا قد وهنت، واتخذت قرارات استراتيجية بإعادة موضعة ذاتها عالمياً، ليس كقوة عظمى مهيمنة ومسيطرة، وزعيمة، بل كقوة تحاول أن تبقى قوة عظمى. لهذا ظلت تنظر من بعيد لما يجري في سوريا، وحين تقدمت تقدمت لكي تقبل بـ «المصالح الحيوية» لروسيا في سوريا، ولتساعد هذه الأخيرة على ترتيب سلطة بديلة هي مهيمنة عليها تحقق المصالح التي اقتنصتها من السلطة الحالية وهي في «زنقة» فظيعة.
لقد أصبح واضحاً، كما تقرر الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، أن أولوياتها هي منطقة آسيا والمحيط الهادي «الباسيفيك»، وأنها لم تعد قادرة على خوض حروب متعددة، بل إنها لا تزال عالقة في حرب واحدة في أفغانستان. هذا الأمر يجعل استخدام القوة خارج أولوياتها أمراً غير مرجح، سوى بالصواريخ والطائرات «عند الضرورة» فقط. وإذا كانت أمريكا قد عملت كسمسار لروسيا من أجل ترتيب الوضع الإقليمي والدولي لكي يقبل بالحل الروسي في سوريا «بيانات مجموعة الثمانية» و«أصدقاء سوريا»، وتأييد تركيا وفرنسا، البلدين -مع قطر المبعدة- اللذين طمحا في السيطرة، وترتيب وضع الائتلاف الوطني للموافقة على جنيف2، فقد ظهر أن السلطة ماضية في الحسم العسكري بتحريض من إيران وبدعم روسي، وأنها تريد السيطرة على الأرض قبل بدء المؤتمر في جنيف، وحين فشلت في السيطرة بعد النجاح الذي حققته في القصير، وقبيل لقاء ترتيب مؤتمر جنيف على مستوى الخبراء بين أمريكا وروسيا (يوم 8/26) استخدمت السلاح الكيماوي لتحقيق انتصار جديد تحتاجه وهي مضطرة للذهاب إلى المؤتمر، معتمدة بأن روسيا ستحميها كما في السابق، وأن أمريكا لم تعد في وارد التدخل.
هذا الأمر شكّل إرباكاً شديداً لوضع أمريكا، خصوصاً بعد الإرباك المصري والخشية من ضياع مصر، فقد أعلن أوباما بأن الكيماوي خط أحمر، وتغاضى مرات قبل ذلك معتمداً على الضبط الروسي للسلطة، لكن ظهر أن أمريكا تندحر مهزومة من المنطقة، لهذا كان التدخل العسكري هو أمر ضروري من أجل استعادة «الهيبة»، وربما تحقيق الضبط في مصر مقابل جر السلطة بقوة أكبر إلى جنيف2. أوباما كان واضحاً بأن الضربة لا تهدف إلى إسقاط النظام وأن حل الأزمة هو عبر الحوار في جنيف2.
أظهرت أمريكا «الهيبة» الضرورية، وبالتالي سواء تخلت عن الضربة العسكرية أو قامت بها فقد حققت ما أرادت، وأكثر: أي شطب الأسلحة الكيماوية السورية، لمصلحة الدولة الصهيونية.
(الشرق)
الممانعون أكدوا روايتهم التي حفظوها عن ظهر قلب، وعجزوا عن نسيانها رغم تحولات الزمن. فقد أكدوا «المؤامرة الإمبريالية» على «سوريا الأسد». فرحوا كثيراً بأن هلوساتهم صحيحة، وأن الإمبريالية الأمريكية ما زالت تعمل على فرض الفوضى الخلاقة و«الشرق الأوسط الموسّع»، وعلى التقسيم والتفتيت الطائفي، وسايكس بيكو رقم 2. باختصار طاشوا، لكن سلطتهم كانت ترتعب من الخوف، فقد واجهت ما جاهدت منذ بدء الثورة لتلافيه: التدخل الإمبريالي، ليس حماية للوطن، بل خوفاً على السلطة ذاتها. فهي تعرف بأن دخول أمريكا على خط المواجهة يعني نهايتها بالحتم، لهذا ساومت روسيا منذ بدء الثورة على أن تعطيها ما تريد مقابل حمايتها دولياً، وفي مجلس الأمن خصوصاً. لهذا عقدت اتفاقات اقتصادية معها ترهن سوريا لروسيا ككل الاتفاقات الإمبريالية. وبتوقيع «الماركسي المرّ» قدري جميل.
وحين اطمأنت للحماية الروسية، ولعدم رغبة أمريكا في الدخول على خط الصراع، قررت تطوير العنف والانتقال إلى مرحلة التدمير الشامل والقتل الشامل. خصوصاً وهي تلاقي الهزائم على الأرض نتيجة تصاعد قوة الثورة، وزيادة دور العمل المسلح.
لكن فجأة ظهر بأن أمريكا مصممة على توجيه ضربة عسكرية بعد أن أخطأت السلطة الحساب واستخدمت السلاح الكيماوي في لحظة كانت تبدو قاسية على أمريكا. لهذا هرعت إلى موسكو من أجل إيجاد حل، خصوصاً بعد أن أعلن الروس بأنهم لن يشاركوا في الحرب دفاعاً عن السلطة السورية، وقاموا بوقف صفقات أسلحة متطورة، وسحبوا قطعهم البحرية من ميناء طرطوس.
حصلت أمريكا على تنازل عن كل الأسلحة الكيماوية. وإذا كان مبكراً التأكيد على جدية التنفيذ فإن مجرد الإقرار بالتسليم هو تأكيد على أن السلطة هي التي استخدمت هذا السلاح في الغوطة «حتى دون أن تشير وهي تقرر تسليمه إلى الجيش الحر الذي ادعت أنه هو من استخدم الكيماوي». وأيضاً لا شك في أن سهولة التسليم بهذا الحل تشير إلى أنها تعبر أن السلطة أهم من «التوازن الاستراتيجي» مع الدولة الصهيونية، ومن الأمن القومي.
بالتالي «المؤامرة» اكتملت حسب منطق كل الممانعين «لفظاً». وباتت الضربة حتمية، ولهذا فقد بدأت «المعركة القومية» ضد الإمبريالية. وبدأ الحديث عن «الرد الصاعق» من قبل حزب الله وإيران، ومن السلطة ذاتها التي ضربتها الطائرات الصهيونية مرات كثيرة وما زالت تبحث عن «الوقت المناسب» للرد.
إذن، بات أمر «الغزو» محسوماً، ومعه بدأت الركب في الاصطقاق، لكن في سيمفونية «قومية»، «نضالية» كثيرة الضجيج.
في المقابل، طارت المعارضة الخارجية «وبعض الداخلية» فرحاً، حيث تحقق «الحلم الطويل» الذي رافقها منذ بدء الثورة. فقد نادت بالتدخل العسكري طويلاً «وهي في ذلك كانت تضرّ الثورة كثيراً»، ورهنت انتصارها بدور القوى الإمبريالية وليس بقدرة الشعب، فقد كان العجز مرضها العضال، وكانت ثقتها بالشعب هي ما دون الصفر. لهذا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الأسد، والسعي لتسلم السلطة. وأصبح السؤال الذي يطرح في صفوف المعارضة هو هل نستطيع بناء سلطة بديلة، وإذا انهارت السلطة هل نحن قادرون على إقامة سلطة جديدة؟
لقد ارتفعت المعنويات إلى السماء، وبات إسقاط النظام قاب قوسين أو أدنى كما يقال. أخيراً «عادت أمريكا إلى رشدها»، هذا هو مكنون كل هؤلاء العجزة الذين ظلوا ينتظرون من يأتي بهم إلى السلطة «ولو على الدبابة الأمريكية».
في كل ذلك ظهر أن الأمر بات محسوماً، وأن الضربة حتمية حتى بعد تصويت مجلس العموم البريطاني ضد مشاركة بريطانيا في الحرب. ورغم «تنكيشات» الكونجرس، والجو الشعبي العام في أوروبا وأمريكا ضد الحرب. ولقد انقسم «العالم» مع الضربة أو ضدها. وأصبح هذا هو مقياس تصنيف، وأساس تحديد الوطنية أو الحرية.
لكن فجأة توقف كل شيء. فقد رمى جون كيري «فكرة عابرة» التقطها سيرغي لافروف وباتت مبادرة روسية، جوهرها فرض الرقابة على الأسلحة الكيماوية في سوريا، والعمل على تدميرها، ومن ثم انضمام سوريا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية. وافق وليد المعلم الذي هرع إلى موسكو بعد «العين الحمرا» الأمريكية، وجرى اعتبار الخطوة حدثاً مهماً جعل أوباما يطلب تأجيل اتخاذ قرار في مجلس الشيوخ بتفويضه بالضربة العسكرية. أوروبا تحمست، وأمريكا بدت مهتمة، و«تغلب الحل الديبلوماسي» على الحرب. الممانعون هللوا لـ «النصر»، حيث أفشلت الخطة الأمريكية لـ «تدمير سوريا» (وكأن هناك ما بقي لكي تدمره الإمبريالية)، ولإسقاط النظام. بتجاهل مفرط لتنازل السلطة عن «سلاح ردع» في مواجهة الدولة الصهيونية، وبتنفس الصعداء لأن السلطة لم تسقط نتيجة الضربة المحتملة كما كان يسكن قعر وعيهم.
والمعارضة التي تفاءلت كثيراً أصيبت بصدمة قوية، حيث أصبح حلمها سراباً. ساد اليأس، وانكشفت كقوى تنادي باحتلال بلدها.
المشكلة تمثلت في أن كل هذا «الجو» كان نتاج تحليل مفرط في الخطأ، ينطلق من رؤية أمريكا وكأنها أمريكا العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين. أمريكا التي تريد السيطرة على العالم بقوتها العسكرية وتفوقها التكنولوجي. بينما كانت أمريكا قد وهنت، واتخذت قرارات استراتيجية بإعادة موضعة ذاتها عالمياً، ليس كقوة عظمى مهيمنة ومسيطرة، وزعيمة، بل كقوة تحاول أن تبقى قوة عظمى. لهذا ظلت تنظر من بعيد لما يجري في سوريا، وحين تقدمت تقدمت لكي تقبل بـ «المصالح الحيوية» لروسيا في سوريا، ولتساعد هذه الأخيرة على ترتيب سلطة بديلة هي مهيمنة عليها تحقق المصالح التي اقتنصتها من السلطة الحالية وهي في «زنقة» فظيعة.
لقد أصبح واضحاً، كما تقرر الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، أن أولوياتها هي منطقة آسيا والمحيط الهادي «الباسيفيك»، وأنها لم تعد قادرة على خوض حروب متعددة، بل إنها لا تزال عالقة في حرب واحدة في أفغانستان. هذا الأمر يجعل استخدام القوة خارج أولوياتها أمراً غير مرجح، سوى بالصواريخ والطائرات «عند الضرورة» فقط. وإذا كانت أمريكا قد عملت كسمسار لروسيا من أجل ترتيب الوضع الإقليمي والدولي لكي يقبل بالحل الروسي في سوريا «بيانات مجموعة الثمانية» و«أصدقاء سوريا»، وتأييد تركيا وفرنسا، البلدين -مع قطر المبعدة- اللذين طمحا في السيطرة، وترتيب وضع الائتلاف الوطني للموافقة على جنيف2، فقد ظهر أن السلطة ماضية في الحسم العسكري بتحريض من إيران وبدعم روسي، وأنها تريد السيطرة على الأرض قبل بدء المؤتمر في جنيف، وحين فشلت في السيطرة بعد النجاح الذي حققته في القصير، وقبيل لقاء ترتيب مؤتمر جنيف على مستوى الخبراء بين أمريكا وروسيا (يوم 8/26) استخدمت السلاح الكيماوي لتحقيق انتصار جديد تحتاجه وهي مضطرة للذهاب إلى المؤتمر، معتمدة بأن روسيا ستحميها كما في السابق، وأن أمريكا لم تعد في وارد التدخل.
هذا الأمر شكّل إرباكاً شديداً لوضع أمريكا، خصوصاً بعد الإرباك المصري والخشية من ضياع مصر، فقد أعلن أوباما بأن الكيماوي خط أحمر، وتغاضى مرات قبل ذلك معتمداً على الضبط الروسي للسلطة، لكن ظهر أن أمريكا تندحر مهزومة من المنطقة، لهذا كان التدخل العسكري هو أمر ضروري من أجل استعادة «الهيبة»، وربما تحقيق الضبط في مصر مقابل جر السلطة بقوة أكبر إلى جنيف2. أوباما كان واضحاً بأن الضربة لا تهدف إلى إسقاط النظام وأن حل الأزمة هو عبر الحوار في جنيف2.
أظهرت أمريكا «الهيبة» الضرورية، وبالتالي سواء تخلت عن الضربة العسكرية أو قامت بها فقد حققت ما أرادت، وأكثر: أي شطب الأسلحة الكيماوية السورية، لمصلحة الدولة الصهيونية.
(الشرق)









