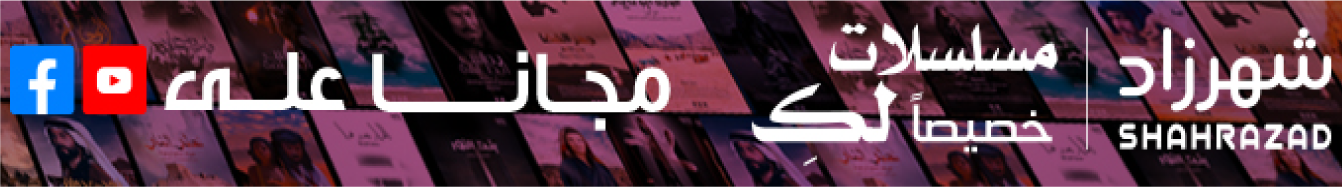عن بوسطن وتفجيراتها وحمّى الإرهاب

ياسر الزعاترة
جو 24 : عندما وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة، لم تمض ساعة حتى أعلن جورج بوش أن القاعدة هي من تقف وراء الهجمات، بينما تلكأ أوباما في إعلان هوية المسؤولين عن تفجيرات بوسطن قبل أيام.
ذهب البعض إلى أن ذلك عائد إلى عقلانية أوباما مقابل جنون بوش وهوسه بقضية الإرهاب، الأمر الذي يرتبط بأجندته السياسية التي كان يحركها المحافظون الجدد لحساب الكيان الصهيوني، بينما تقول قراءة أعمق لما جرى إنه لا بوش، ولا أوباما هو المسؤول عن تحديد هوية المسؤول عن الهجمات؛ أية هجمات، بل هي مهمة أجهزة الأمن التي تنقل قناعتها للرئيس؛ أي رئيس.
في الحالة الأولى، لم يكن بوش هو فقط من ذهب ذلك المذهب، فقد نسبنا نحن أيضا العمليات للقاعدة، وبالطبع تبعا لمعطيات كانت متاحة في ذلك الحين، بينما تردد أوباما، وترددنا معه في نسبة تفجيرات بوسطن إليها أو إلى شبان عرب ومسلمين لأن المعطيات لا تحسم ذلك، وإن أبقت الاحتمال قائما، ولا يمكن استبعاده.
في تلك الأثناء كان أسامة بن لادن قد أعلن حربا مفتوحة على الولايات المتحدة بوصفها “رأس الكفر” الذي يستهدف المسلمين، بصرف النظر عن تبريرات ذلك، وفي المقدمة دعمها للكيان الصهيوني في وقت كانت انتفاضة الأقصى في ذروة صعودها، وكان العالم الإسلامي يتابعها بكل مشاعره، هي التي كانت فعالياتها تبث على الهواء مباشرة في ظل ثورة إعلام جديدة في ذلك الحين، تماما كما يتابع هذه الأيام حيثيات الثورة السورية، مع خصوصية للقضية الفلسطينية في الوعي الجمعي للأمة (تتقدم القضية السورية هذه الأيام من دون شك نظرا للجمود الذي تعيشه قضية فلسطين، في مقابل التضحيات الجسام التي يقدمها السوريون في مواجهة نظام مجرم).
في الحالة الأولى، لم يكن وقت طويل قد مضى على إعلان قاعدة الجهاد كتحالف عملي بين مجموعة بن لادن، وبقايا تنظيم الجهاد المصري، حيث أقنع الأول الأخير بالكف عن مطاردة العدو القريب (النظام المصري)، والانشغال بالعدو البعيد الأكثر أهمية (الولايات المتحدة)، وكانت عمليات كبرى قد سبقت هجمات أيلول هي تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، وضرب المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في ميناء عدن.
منذ هجمات أيلول، دفعت الولايات المتحدة عشرات المليارات في مطاردة ما تسميه الإرهاب، لا أعني خارج الولايات المتحدة في أفغانستان (حساب هاتين المعركتين أكبر بكثير)، بل داخلها، وهي نجحت في منع أية عملية جديدة من العيار الثقيل، وما جرى منذ ذلك الحين هي محاولات بسيطة تم معظمها بمبادرات فردية عبر شبان استلهموا فكر القاعدة، مثل عمر الفاروق وصولا إلى عملية الضابط الأمريكي (من أصل فلسطيني) نضال حسن الذي أطلق الرصاص على جنود آخرين في قاعدة فورت هود الأمريكية، بل إن أكثر الإعلانات عن إحباط عمليات إرهابية كانت في معظمها كاذبة، حيث يجري استدراج شبان مسلمين عبر عملاء الإف بي آي من خلال إقناعهم بالجهاد، ثم يجري اعتقالهم دون أن يفعلوا شيئا.
في تفجيرات بوسطن لم تعلن أجهزة الأمن الأمريكية نسبة العمليات لتنظيم القاعدة، ربما ثقة منها بأنها سدت جميع المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها من يفكرون في تنفيذ عملية داخل الولايات المتحدة، في ذات الوقت الذي تدرك فيه أن فكرة العمليات هنا لم تعد تسيطر على عقل الشبان الذين يفكرون في الجهاد، والذين باتت جبهة سوريا تستقطبهم أكثر، في ذات الوقت الذي تراجع فيه فكر العدو البعيد لصالح العودة إلى العدو القريب من جديد.
من هنا، كان الميل إلى أن تفجيرات بوسطن هي من تنفيذ مليشيات محلية يمينية (تتوفر بكثرة في الولايات المتحدة، ويقال إن عددها يصل إلى 300)، لاسيما أن العبوات كانت بدائية، مع أن البعد الأخير لا ينفي طبعا إمكانية تنفيذ العملية من قبل شبان عرب ومسلمين لم يكونوا من النوع الخاضع للرقابة وتعلموا طريقة الإعداد عبر الإنترنت، أكانوا مقيمين أم قادمين من الخارج، لاسيما أن من الصعب القول إن أمريكا قد غادرت مربع العداء للعرب والمسلمين في وعيهم الجمعي، هي التي لا زالت تقف بكل قوتها إلى جانب الكيان الصهيوني، فيما لم تخرج من أفغانستان، وفيما تمارس طائراتها بدون طيار عمليات قتل متواصلة في أكثر من دولة عربية وإسلامية، مع موقف أقرب إلى دعم النظام في سوريا منه إلى دعم الثورة.
بصرف النظر عن الموقف من قضية استهداف المدنيين غير المحاربين، والتي ترفضها غالبية العلماء والقوى السياسية، فإن عموم الجماهير لم تعد تنظر بعين الارتياح إلى عمليات داخل الدول الغربية، ليس فقط لتأثيرها السلبي على الجاليات المسلمة، بل أيضا لوجود أولويات أخرى أكثر إلحاحا.
تبقى الإشارة إلى انشغال العالم لبعض الوقت بالتفجيرات رغم أنها لم تؤد سوى إلى عدد محدود من الضحايا، بينما يسكت على ما يجري من استباحة لدماء الأبرياء في سوريا، وهو ما يعكس مجاملة القوي على حساب الضعفاء، أو ازدواجية المعايير كما دأب الناس على القول.
(الدستور)
ذهب البعض إلى أن ذلك عائد إلى عقلانية أوباما مقابل جنون بوش وهوسه بقضية الإرهاب، الأمر الذي يرتبط بأجندته السياسية التي كان يحركها المحافظون الجدد لحساب الكيان الصهيوني، بينما تقول قراءة أعمق لما جرى إنه لا بوش، ولا أوباما هو المسؤول عن تحديد هوية المسؤول عن الهجمات؛ أية هجمات، بل هي مهمة أجهزة الأمن التي تنقل قناعتها للرئيس؛ أي رئيس.
في الحالة الأولى، لم يكن بوش هو فقط من ذهب ذلك المذهب، فقد نسبنا نحن أيضا العمليات للقاعدة، وبالطبع تبعا لمعطيات كانت متاحة في ذلك الحين، بينما تردد أوباما، وترددنا معه في نسبة تفجيرات بوسطن إليها أو إلى شبان عرب ومسلمين لأن المعطيات لا تحسم ذلك، وإن أبقت الاحتمال قائما، ولا يمكن استبعاده.
في تلك الأثناء كان أسامة بن لادن قد أعلن حربا مفتوحة على الولايات المتحدة بوصفها “رأس الكفر” الذي يستهدف المسلمين، بصرف النظر عن تبريرات ذلك، وفي المقدمة دعمها للكيان الصهيوني في وقت كانت انتفاضة الأقصى في ذروة صعودها، وكان العالم الإسلامي يتابعها بكل مشاعره، هي التي كانت فعالياتها تبث على الهواء مباشرة في ظل ثورة إعلام جديدة في ذلك الحين، تماما كما يتابع هذه الأيام حيثيات الثورة السورية، مع خصوصية للقضية الفلسطينية في الوعي الجمعي للأمة (تتقدم القضية السورية هذه الأيام من دون شك نظرا للجمود الذي تعيشه قضية فلسطين، في مقابل التضحيات الجسام التي يقدمها السوريون في مواجهة نظام مجرم).
في الحالة الأولى، لم يكن وقت طويل قد مضى على إعلان قاعدة الجهاد كتحالف عملي بين مجموعة بن لادن، وبقايا تنظيم الجهاد المصري، حيث أقنع الأول الأخير بالكف عن مطاردة العدو القريب (النظام المصري)، والانشغال بالعدو البعيد الأكثر أهمية (الولايات المتحدة)، وكانت عمليات كبرى قد سبقت هجمات أيلول هي تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، وضرب المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في ميناء عدن.
منذ هجمات أيلول، دفعت الولايات المتحدة عشرات المليارات في مطاردة ما تسميه الإرهاب، لا أعني خارج الولايات المتحدة في أفغانستان (حساب هاتين المعركتين أكبر بكثير)، بل داخلها، وهي نجحت في منع أية عملية جديدة من العيار الثقيل، وما جرى منذ ذلك الحين هي محاولات بسيطة تم معظمها بمبادرات فردية عبر شبان استلهموا فكر القاعدة، مثل عمر الفاروق وصولا إلى عملية الضابط الأمريكي (من أصل فلسطيني) نضال حسن الذي أطلق الرصاص على جنود آخرين في قاعدة فورت هود الأمريكية، بل إن أكثر الإعلانات عن إحباط عمليات إرهابية كانت في معظمها كاذبة، حيث يجري استدراج شبان مسلمين عبر عملاء الإف بي آي من خلال إقناعهم بالجهاد، ثم يجري اعتقالهم دون أن يفعلوا شيئا.
في تفجيرات بوسطن لم تعلن أجهزة الأمن الأمريكية نسبة العمليات لتنظيم القاعدة، ربما ثقة منها بأنها سدت جميع المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها من يفكرون في تنفيذ عملية داخل الولايات المتحدة، في ذات الوقت الذي تدرك فيه أن فكرة العمليات هنا لم تعد تسيطر على عقل الشبان الذين يفكرون في الجهاد، والذين باتت جبهة سوريا تستقطبهم أكثر، في ذات الوقت الذي تراجع فيه فكر العدو البعيد لصالح العودة إلى العدو القريب من جديد.
من هنا، كان الميل إلى أن تفجيرات بوسطن هي من تنفيذ مليشيات محلية يمينية (تتوفر بكثرة في الولايات المتحدة، ويقال إن عددها يصل إلى 300)، لاسيما أن العبوات كانت بدائية، مع أن البعد الأخير لا ينفي طبعا إمكانية تنفيذ العملية من قبل شبان عرب ومسلمين لم يكونوا من النوع الخاضع للرقابة وتعلموا طريقة الإعداد عبر الإنترنت، أكانوا مقيمين أم قادمين من الخارج، لاسيما أن من الصعب القول إن أمريكا قد غادرت مربع العداء للعرب والمسلمين في وعيهم الجمعي، هي التي لا زالت تقف بكل قوتها إلى جانب الكيان الصهيوني، فيما لم تخرج من أفغانستان، وفيما تمارس طائراتها بدون طيار عمليات قتل متواصلة في أكثر من دولة عربية وإسلامية، مع موقف أقرب إلى دعم النظام في سوريا منه إلى دعم الثورة.
بصرف النظر عن الموقف من قضية استهداف المدنيين غير المحاربين، والتي ترفضها غالبية العلماء والقوى السياسية، فإن عموم الجماهير لم تعد تنظر بعين الارتياح إلى عمليات داخل الدول الغربية، ليس فقط لتأثيرها السلبي على الجاليات المسلمة، بل أيضا لوجود أولويات أخرى أكثر إلحاحا.
تبقى الإشارة إلى انشغال العالم لبعض الوقت بالتفجيرات رغم أنها لم تؤد سوى إلى عدد محدود من الضحايا، بينما يسكت على ما يجري من استباحة لدماء الأبرياء في سوريا، وهو ما يعكس مجاملة القوي على حساب الضعفاء، أو ازدواجية المعايير كما دأب الناس على القول.
(الدستور)