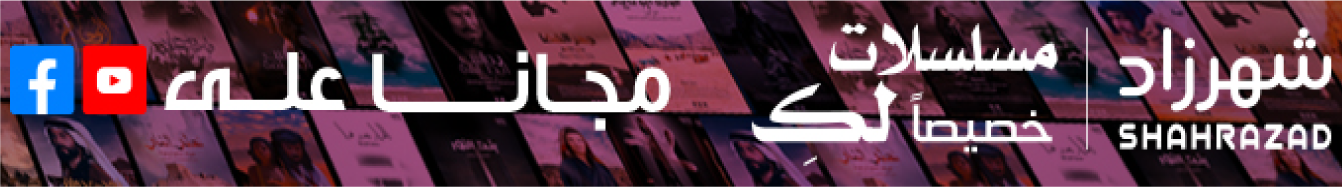الحنين إلى المنفى!!

خيري منصور
جو 24 : لا أدري ما اذا كنت بكيت حتى الضحك أو العكس عندما سمعت المهاجرين الفلسطينيين من مخيم اليرموك في سورية الى مخيمات لبنان وبالتحديد برج البراجنة، فالبكاء هذه المرة وبعد ستة عقود عجاف على أطلال مخيم وليس على وطن والمفاضلة والمقارنة ليست بين مسقط رأس ومنفى، بل بين مخيم وآخر، وهذا يذكرنا بما قاله الشهيد غسان كنفاني قبل أكثر من أربعين سنة، وهو خيمة عن خيمة تفرق.
من فروا للنجاة بأطفالهم من مخيم اليرموك في دمشق الى لبنان منهم من أصبح مسقط رأسه المخيم، والقلة منهم فقط من تصطحب الذكريات عن البيت الأول، لهذا قالت امرأة ان مخيم اليرموك هو البلد ولم تكن تلك زلة لسان، بقدر ما هي زلة زمان وثقافة وقنوط، فمن ولدوا في مخيم لا يعرفون سواه، رغم أنهم استعاضوا بالخيال عن الذاكرة وابتكروا فكرة الوطن قبل الوطن ذاته من آلامهم وليس من الحنين.
هكذا هي الرحلة إذن من مخيم الى مخيم الى مخيم، والعودة أعيد انتاج مدلولاتها بحيث أصبحت تعني العودة الى المخيم الأول، كيف حدث ذلك؟ وبأية ثقافة وبأية حيثيات أو مكائد، حوّلت الهجرة الى فخّ.. مثلما حوّلت المستقبل الى كمين لفرط غموضه، والتعامل معه بقراءة حثالة القهوة في الفناجين وليس من خلال دراسات مستقبلية ترى في القادم تحقيقاً لممكنات الراهن، اللهم إلا إذا تسلل العبث بالجينات الى التاريخ فأصبحت العودة الى مخيم مثلما طرح الكوسا برتقالاً وأصبح للورد رائحة المطاط!!
فهل هي مأساة مونت كريستو الذي حفر في زنزانته أعواماً ليجد نفسه في زنزانة أضيق وأشد رطوبة؟
عوامل كثيرة تحالفت لاعطاب البوصلة مثلما تحالفت لتغيير وجهة الحجر والبندقية والكراهية.
لقد أعد العرب لمن يهاجرون من بني جلدتهم خياماً فقط، أما القوة ورباط الخيل فهي خارج السياق والمكان والزمان!
أما سؤال درويش المشحون بالأسى والسخرية فهو: لماذا تعبس المدينة الكبيرة حين يبتسم المخيم..؟؟؟
لكن الاجابة الماكرة على ذلك السؤال جاءت من تاريخ مصاب بالزهايمر وفقدان المناعة، بعد أن جاعت المرأة فأكلت بثدييها وبعد أن تحققت نبوءة تلك الجدة الحكيمة عندما قالت «صرنا بين القوم معيرة، العبد يحمي الحر والحرّ يضرب مرة».
فالمدن الكبيرة الآن تبتسم، وما يعبس هو المخيم الذي لم يعد فلسطينيا فقط، فنحن أمة من اللاجئين وتاريخنا يبدأ بالهجرة، لكن بلا أنصار!!
(الدستور)
من فروا للنجاة بأطفالهم من مخيم اليرموك في دمشق الى لبنان منهم من أصبح مسقط رأسه المخيم، والقلة منهم فقط من تصطحب الذكريات عن البيت الأول، لهذا قالت امرأة ان مخيم اليرموك هو البلد ولم تكن تلك زلة لسان، بقدر ما هي زلة زمان وثقافة وقنوط، فمن ولدوا في مخيم لا يعرفون سواه، رغم أنهم استعاضوا بالخيال عن الذاكرة وابتكروا فكرة الوطن قبل الوطن ذاته من آلامهم وليس من الحنين.
هكذا هي الرحلة إذن من مخيم الى مخيم الى مخيم، والعودة أعيد انتاج مدلولاتها بحيث أصبحت تعني العودة الى المخيم الأول، كيف حدث ذلك؟ وبأية ثقافة وبأية حيثيات أو مكائد، حوّلت الهجرة الى فخّ.. مثلما حوّلت المستقبل الى كمين لفرط غموضه، والتعامل معه بقراءة حثالة القهوة في الفناجين وليس من خلال دراسات مستقبلية ترى في القادم تحقيقاً لممكنات الراهن، اللهم إلا إذا تسلل العبث بالجينات الى التاريخ فأصبحت العودة الى مخيم مثلما طرح الكوسا برتقالاً وأصبح للورد رائحة المطاط!!
فهل هي مأساة مونت كريستو الذي حفر في زنزانته أعواماً ليجد نفسه في زنزانة أضيق وأشد رطوبة؟
عوامل كثيرة تحالفت لاعطاب البوصلة مثلما تحالفت لتغيير وجهة الحجر والبندقية والكراهية.
لقد أعد العرب لمن يهاجرون من بني جلدتهم خياماً فقط، أما القوة ورباط الخيل فهي خارج السياق والمكان والزمان!
أما سؤال درويش المشحون بالأسى والسخرية فهو: لماذا تعبس المدينة الكبيرة حين يبتسم المخيم..؟؟؟
لكن الاجابة الماكرة على ذلك السؤال جاءت من تاريخ مصاب بالزهايمر وفقدان المناعة، بعد أن جاعت المرأة فأكلت بثدييها وبعد أن تحققت نبوءة تلك الجدة الحكيمة عندما قالت «صرنا بين القوم معيرة، العبد يحمي الحر والحرّ يضرب مرة».
فالمدن الكبيرة الآن تبتسم، وما يعبس هو المخيم الذي لم يعد فلسطينيا فقط، فنحن أمة من اللاجئين وتاريخنا يبدأ بالهجرة، لكن بلا أنصار!!
(الدستور)