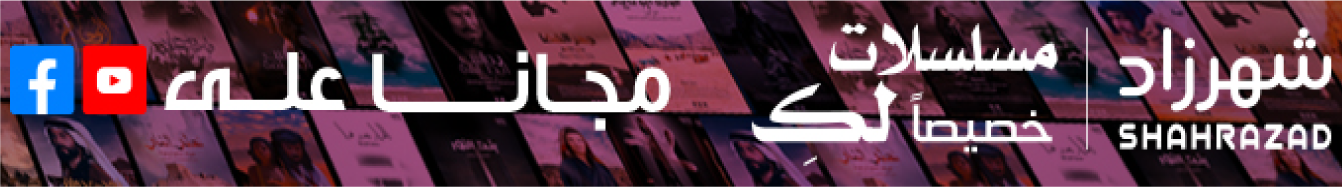كاريكاتير يجيب على أسئلة حائرة..!!

حسين الرواشدة
جو 24 : لم يخطر في بالي أبدا أن أجيب على سؤالين يلحان علي منذ زمن طويل، أحدهما يتعلق بما حدث في عالمنا العربي من تحولات سواء من جهة أسبابها ودوافعها ومساراتها أو من جهة مآلاتها ونتائجها، والسؤال الآخر هو مصير الحراكات الشعبية في عالمنا العربي: هل ماتت أم احتضرت أم أنها اختارت الكمون والهدوء المؤقت..لكن حين أعدت قراءة بعض ما لدي من قصاصات احتفظ بها وجدت كاريكاتيرا مثيرا نشرته إحدى الصحف الفرنسية قبل عدة أعوام (وقد كتبت عنه حينها) كجزء من استحضار الذاكرة التاريخية للأزمة التي كانت محتدمة بين فرنسا وألمانيا قبل نحو مئة عام.
في الكاريكاتير ظهرت صورتان: الأولى لمطعم يرتاده مختلف أطياف المجتمع الفرنسي ، وبدت الجلسة دافئة جدا ، حيث يأكل الجالسون ويتسامرون بمنتهى الانسجام والألفة، أما الصورة الثانية فقد بدت للمطعم ذاته ، لكن الانسجام تحوّل فيها الى صراع ومشاكسات ، وظهر الوجوم والخوف والكراهية المتبادلة على كافة الوجوه.. وبين الصورتين كُتبت عبارة واحدة “حين تكلموا بالقضية”.
الرسام الفرنسي - آنذاك - كان يستمد فكرته من حدث انشغل به الفرنسيون على اختلاف مذاهبهم السياسية والاجتماعية والعرقية ، حيث اتهم أحد الضباط المشهورين بالخيانة لحساب ألمانيا (اسمه النقيب ألفريد دريفوس) وانقسم الفرنسيون - خلال اثني عشر عامًا من 1894 وحتى 1906- بين مؤيد للتهمة ومحرض على محاكمة الرجل ومحاسبته، وبين متعاطف معه ومقدر لبطولته ومطالب بعدم محاسبته.. والكل كان يدافع عن صورة ألمانيا وسمعتها مع اختلاف النوايا والزوايا طبعا.
عرفت هذه القضية آنذاك باسم الضابط المتهم (دريفوس) وفي التفاصيل، ان عاملة نظافة تعمل في السفارة الألمانية أرسلت محتويات سلة مهملات وجدتها في إحدى الغرف إلى نائب مدير المكتب الفرنسي لمكافحة التجسس واكتشف الأخير أنها احتوت على خمس وثائق كان رجل مجهول يرغب في بيعها للسفارة الألمانية، وعند مقارنة الخطوط وجد أن خط أحد المتهمين وهو الكابتن الفرنسي من أصول يهودية ألفريد دريفوس يماثل خط المذكرة وتم القبض عليه ومحاكمته.
ومع أن دريفوس ظل يصرُّ على براءته دائما إلا أن المحكمة أصدرت عليه حكما بتجريده من رتبته العسكرية ومغادرة فرنسا نهائيا وسجنه مدى الحياة في سجن الشيطان.
وبعد أعوام وجَّه المثقفون الفرنسيون باسم اميل زولا خطابا بعنوان “اني اتهم” مطالبين بتبرئة الضابط،. فأعيدت محاكمته وبُرِّئ من التهمة لكن الجيش رفض الاعتراف بالحكم فأصدرت محكمة عسكرية ثانية حكماً عليه بالسجن لعشرة أعوام، ثم أفرج عنه بعدها بعفو من الرئيس الفرنسي آنذاك.
القضية- بالطبع- لم تكن تستحق ما حدث من انقسام في الشارع الفرنسي ، والاختلاف حول براءة الضابط من عدمها لم تكن لتبرر مثل هذا الانقسام السياسي والاجتماعي ، لكن المجتمع الفرنسي كان وقتها بحاجة الى قضية، أي قضية يعلق عليها ما تراكم داخله من انكسارات وهزائم، أو قناة مفتوحة ينفس من خلالها احتقاناته السياسية وإحساسه بالظلم والخوف .
بوسع الذين يبحثون عن إجابة لما حدث في عالمنا العربي أو لما قد يحدث أن يتأملوا في القصة ذاتها ، وربما يكتشفون- مثلي تماما - ان المجتمعات حتى في أوج حراكاتها يمكن أن تتجاوز المحن الكبرى ، او ان تبتلع اخفاقاتها وتبرر اخطاءها ، وتتسامح مع المسؤولين عنها ، لكن ما يميز تلك الحراكات الاجتماعية انها تحتفظ في ذاكرتها بكل ما ابتلعته ، وحين تحاول أن تهضمه وتصاب بالعسر تبحث عن تلك القشة او تنتظرها ، فتفرغ كل ما بداخلها ، سواء على شكل انفجارات أو انهيارات ، وبذكائها الفطري تمسك بأي طرف للخيط ، وتختار فريستها بدقة ومهارة ، فإذا ما جاءت اللحظة المناسبة وعثرت على الضحية المطلوبة لا تسأل هنا - عما إذا كان مخطئا أو بريئا أصبح هو القضية وعليه يكون الانقسام ، اجتماعيا وسياسيا أيضا، وتلك - بالطبع - واحدة من سمات سيكولوجية الجمهور التي لا تظهر إلا في الأزمات الخطيرة ، حيث يأخذ قانون الاستبدال مجراه ، ويصنع الناس رمزا خاصا بهم لافتعال نوع ما من الرفض أو المطالبة بالتغيير.
ما القضية التي يمكن لمجتمعاتنا العربية ان تتحدث عنها، بالطبع هناك قضايا كثيرة، لكن لا احد يستطيع ان يحدد هذه القضية التي ستشكل منعطفا للتغيير كما لا يمكن لأحد ان يتنبأ بموعد الكلام فيها ، ولا بالمدة التي يستغرق فيها الناس بالحديث ..ولا ايضا بالاشخاص المعنيين بها او ما تفضي اليه حركة المجتمع بعدها من تحولات و مآلات.
لكن لا شك أن الثمن الذي تدفعه المجتمعات حين يتكلم الناس في القضية فادح على المستوى الاجتماعي ،(لاحظ ما يحدث في معظم دول الربيع العربي الآن) وأسوأ مظاهره ما يترتب عليه من شروخات في بنية المجتمع وانقسام في مكوناته، والمشكلة هنا ليست-فقط- في القضية ، اذا ما كانت كبيرة او حقيقية او مفتعلة ، ولا في المتهم بريئا أكان أم مخطئا ، مجرما أم ضحية ، ولا في العنوان الذي يختاره المجتمع ، بل في التربة التي خرجت منها والظروف التي أنتجتها ، والتراكمات التي ولدتها ، مع ذلك ، فإن التضحية بأي شيء مقابل عدم الوصول الى اللحظة التي يجد المجتمع نفسه مضطرا للحديث مجددا عن “القضية ، يبدو الحل الوحيد لتجنيب المجتمع دفع ذلك الثمن الباهظ..أما إذا بدأ الحديث وتطور وتراكم فإن الحل سيكون صعبا بامتياز.
(الدستور)
في الكاريكاتير ظهرت صورتان: الأولى لمطعم يرتاده مختلف أطياف المجتمع الفرنسي ، وبدت الجلسة دافئة جدا ، حيث يأكل الجالسون ويتسامرون بمنتهى الانسجام والألفة، أما الصورة الثانية فقد بدت للمطعم ذاته ، لكن الانسجام تحوّل فيها الى صراع ومشاكسات ، وظهر الوجوم والخوف والكراهية المتبادلة على كافة الوجوه.. وبين الصورتين كُتبت عبارة واحدة “حين تكلموا بالقضية”.
الرسام الفرنسي - آنذاك - كان يستمد فكرته من حدث انشغل به الفرنسيون على اختلاف مذاهبهم السياسية والاجتماعية والعرقية ، حيث اتهم أحد الضباط المشهورين بالخيانة لحساب ألمانيا (اسمه النقيب ألفريد دريفوس) وانقسم الفرنسيون - خلال اثني عشر عامًا من 1894 وحتى 1906- بين مؤيد للتهمة ومحرض على محاكمة الرجل ومحاسبته، وبين متعاطف معه ومقدر لبطولته ومطالب بعدم محاسبته.. والكل كان يدافع عن صورة ألمانيا وسمعتها مع اختلاف النوايا والزوايا طبعا.
عرفت هذه القضية آنذاك باسم الضابط المتهم (دريفوس) وفي التفاصيل، ان عاملة نظافة تعمل في السفارة الألمانية أرسلت محتويات سلة مهملات وجدتها في إحدى الغرف إلى نائب مدير المكتب الفرنسي لمكافحة التجسس واكتشف الأخير أنها احتوت على خمس وثائق كان رجل مجهول يرغب في بيعها للسفارة الألمانية، وعند مقارنة الخطوط وجد أن خط أحد المتهمين وهو الكابتن الفرنسي من أصول يهودية ألفريد دريفوس يماثل خط المذكرة وتم القبض عليه ومحاكمته.
ومع أن دريفوس ظل يصرُّ على براءته دائما إلا أن المحكمة أصدرت عليه حكما بتجريده من رتبته العسكرية ومغادرة فرنسا نهائيا وسجنه مدى الحياة في سجن الشيطان.
وبعد أعوام وجَّه المثقفون الفرنسيون باسم اميل زولا خطابا بعنوان “اني اتهم” مطالبين بتبرئة الضابط،. فأعيدت محاكمته وبُرِّئ من التهمة لكن الجيش رفض الاعتراف بالحكم فأصدرت محكمة عسكرية ثانية حكماً عليه بالسجن لعشرة أعوام، ثم أفرج عنه بعدها بعفو من الرئيس الفرنسي آنذاك.
القضية- بالطبع- لم تكن تستحق ما حدث من انقسام في الشارع الفرنسي ، والاختلاف حول براءة الضابط من عدمها لم تكن لتبرر مثل هذا الانقسام السياسي والاجتماعي ، لكن المجتمع الفرنسي كان وقتها بحاجة الى قضية، أي قضية يعلق عليها ما تراكم داخله من انكسارات وهزائم، أو قناة مفتوحة ينفس من خلالها احتقاناته السياسية وإحساسه بالظلم والخوف .
بوسع الذين يبحثون عن إجابة لما حدث في عالمنا العربي أو لما قد يحدث أن يتأملوا في القصة ذاتها ، وربما يكتشفون- مثلي تماما - ان المجتمعات حتى في أوج حراكاتها يمكن أن تتجاوز المحن الكبرى ، او ان تبتلع اخفاقاتها وتبرر اخطاءها ، وتتسامح مع المسؤولين عنها ، لكن ما يميز تلك الحراكات الاجتماعية انها تحتفظ في ذاكرتها بكل ما ابتلعته ، وحين تحاول أن تهضمه وتصاب بالعسر تبحث عن تلك القشة او تنتظرها ، فتفرغ كل ما بداخلها ، سواء على شكل انفجارات أو انهيارات ، وبذكائها الفطري تمسك بأي طرف للخيط ، وتختار فريستها بدقة ومهارة ، فإذا ما جاءت اللحظة المناسبة وعثرت على الضحية المطلوبة لا تسأل هنا - عما إذا كان مخطئا أو بريئا أصبح هو القضية وعليه يكون الانقسام ، اجتماعيا وسياسيا أيضا، وتلك - بالطبع - واحدة من سمات سيكولوجية الجمهور التي لا تظهر إلا في الأزمات الخطيرة ، حيث يأخذ قانون الاستبدال مجراه ، ويصنع الناس رمزا خاصا بهم لافتعال نوع ما من الرفض أو المطالبة بالتغيير.
ما القضية التي يمكن لمجتمعاتنا العربية ان تتحدث عنها، بالطبع هناك قضايا كثيرة، لكن لا احد يستطيع ان يحدد هذه القضية التي ستشكل منعطفا للتغيير كما لا يمكن لأحد ان يتنبأ بموعد الكلام فيها ، ولا بالمدة التي يستغرق فيها الناس بالحديث ..ولا ايضا بالاشخاص المعنيين بها او ما تفضي اليه حركة المجتمع بعدها من تحولات و مآلات.
لكن لا شك أن الثمن الذي تدفعه المجتمعات حين يتكلم الناس في القضية فادح على المستوى الاجتماعي ،(لاحظ ما يحدث في معظم دول الربيع العربي الآن) وأسوأ مظاهره ما يترتب عليه من شروخات في بنية المجتمع وانقسام في مكوناته، والمشكلة هنا ليست-فقط- في القضية ، اذا ما كانت كبيرة او حقيقية او مفتعلة ، ولا في المتهم بريئا أكان أم مخطئا ، مجرما أم ضحية ، ولا في العنوان الذي يختاره المجتمع ، بل في التربة التي خرجت منها والظروف التي أنتجتها ، والتراكمات التي ولدتها ، مع ذلك ، فإن التضحية بأي شيء مقابل عدم الوصول الى اللحظة التي يجد المجتمع نفسه مضطرا للحديث مجددا عن “القضية ، يبدو الحل الوحيد لتجنيب المجتمع دفع ذلك الثمن الباهظ..أما إذا بدأ الحديث وتطور وتراكم فإن الحل سيكون صعبا بامتياز.
(الدستور)