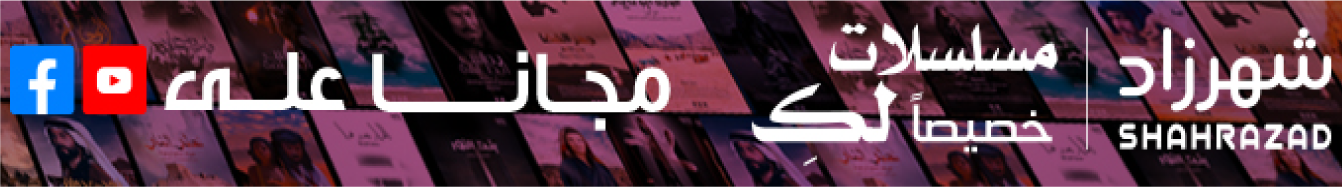الفساد حين يصبح مبرَّرا

جمانة غنيمات
جو 24 : القاعدة السابقة تسقط على مختلف القضايا، ومحاربة الفساد ليست استثناء، إذ يتوفر عدد من التشريعات المهمة ومنها إبراء الذمة المالية، والجرائم الاقتصادية، لكنّ العيب كان دائما في التطبيق، والالتفاف على القوانين.
ما يحدث في الأردن يجري في كثير من دول العالم، إذ كشفت بيانات جديدة للبنك الدولي أن 78 % من البلدان المشمولة في قاعدة البيانات لديها أنظمة للإفصاح المالي، في حين أن 36 % من الدول فحسب تراجع إقرارات الإفصاح المالي لرصد أية مخالفات.
الأردن من بين الدول التي لا تراجع البيانات بهدف رصد الزيادات الطارئة على ثروات وممتلكات المسؤولين بعد تسلمهم للموقع العام، رغم أن الشواهد كثيرة على مظاهر الإثراء التي ظهرت على بعضهم فجأة.
ومع تشكيل كل حكومة وانتخاب مجلس نواب، وتعيين الأعيان، يبادر المسؤولون إلى إبراء ذممهم المالية، لبيان ما يمتلكونه من أصول وموارد مالية، بمجرد تسلمهم الموقع العام.
لكن كم مرة جرت مراجعة هذه البيانات واستخدامها للتحقق من مصادر أموال المسؤولين الذين سرعان ما تظهر عليهم علامات الثراء؟
الإجابة ببساطة أنه لم تسجل سابقة بهذا الخصوص، لتؤكد أن ثمة نفعا من تطبيق القانون، وتحقيق الغاية التي وضع لأجلها، وهي محاسبة المسؤولين في حال تطاولهم على المال العام.
ما يحدث ليس مفاجئا، فنحن من دول العالم الثالث التي تطبق هذه المعايير لغايات إرضاء المؤسسات الدولية، والتغني بأن لديها من الضوابط الشكلية ما يكفي لإقناع هذه المؤسسات والدول المانحة، بأن التشريعات المطبقة تكفي لحماية المال العام.
عمليا، ما يتوفر من تشريعات، لا يعني أن ثمة رقابة حقيقية ومراجعات لكشوف حسابات أرصدة المسؤولين، فالالتزام بالتشريعات صوري لا أكثر.
ضعف المساءلة يرتبط بعوامل أخرى، تتعلق بعدم توفير المعلومات للمواطنين، ما يحد من الرقابة الشعبية على موظفي القطاع العام، ويوفر بيئة خصبة لإطلاق الاشاعات على المسؤولين، بسبب أجواء عدم الثقة السائدة، والتي تدعو للتشكيك بكل ما هو موجود.
اليوم، المطالبة بمزيد من تشريعات النزاهة في أَوْجها، وليس المهم أن تستجيب الحكومة بوضع التشريعات، بقدر تركيزها على التطبيق، الأمر الذي يتطلب وضع منظومة إجرائية لا يُقفَز عنها كما كان يحدث في الماضي، بحيث تضمن الالتزام بالقانون نصا وروحا.
فإذا كان من الصعب استرداد ما نُهِب من المال العام في الماضي، لأن الفاسدين كانوا في غاية الذكاء واستخدموا ما يتيحه القانون من منافذ لقوننة فسادهم، فإن من المهم الآن وضع كل التشريعات والتعليمات التي تمنع ذلك مستقبلا.
لن أتحدث عن شخصيات العيار الثقيل، وسأركز على الموظفين العاديين في وسط السلم الوظيفي في الدوائر الحكومية، ممن باتوا يسكنون الفلل ويمتلكون المزارع، بعد أن تساهلوا بحماية المال العام وسهّلوا الاعتداء عليه، في ظل تفشي ثقافة مجتمعية، تقبل بالفساد وممارساته، تبرره وتشرعنه، كل لأسبابه.
النظرة الجديدة للفساد، وعدم تجريمه مجتمعيا، جعلت التطاول على أموال الخزينة سهلا وبأشكال متعددة، تحقق كسبا ولو قليلا، يبدأ بحفنة دنانير، ولا أحد يعلم أين ينتهي.
قانون "من أين لك هذا؟" مطلب شعبي، بيد أن إقراره دون توفر الإرادة لتطبيقه لن يضيف شيئا لملف محاربة الفساد.
العبرة ليست في كثرة التشريعات بل الالتزام بها، وإحياء الإيمان بكل القيم الأخلاقية التي كانت تقف سدا منيعا في وجه الفساد، وإعادة الهيبة لدولة القانون والمؤسسات، التي لا تتوفر إلا في دولة ديمقراطية، تؤمن بضرورة توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.الغد
ما يحدث في الأردن يجري في كثير من دول العالم، إذ كشفت بيانات جديدة للبنك الدولي أن 78 % من البلدان المشمولة في قاعدة البيانات لديها أنظمة للإفصاح المالي، في حين أن 36 % من الدول فحسب تراجع إقرارات الإفصاح المالي لرصد أية مخالفات.
الأردن من بين الدول التي لا تراجع البيانات بهدف رصد الزيادات الطارئة على ثروات وممتلكات المسؤولين بعد تسلمهم للموقع العام، رغم أن الشواهد كثيرة على مظاهر الإثراء التي ظهرت على بعضهم فجأة.
ومع تشكيل كل حكومة وانتخاب مجلس نواب، وتعيين الأعيان، يبادر المسؤولون إلى إبراء ذممهم المالية، لبيان ما يمتلكونه من أصول وموارد مالية، بمجرد تسلمهم الموقع العام.
لكن كم مرة جرت مراجعة هذه البيانات واستخدامها للتحقق من مصادر أموال المسؤولين الذين سرعان ما تظهر عليهم علامات الثراء؟
الإجابة ببساطة أنه لم تسجل سابقة بهذا الخصوص، لتؤكد أن ثمة نفعا من تطبيق القانون، وتحقيق الغاية التي وضع لأجلها، وهي محاسبة المسؤولين في حال تطاولهم على المال العام.
ما يحدث ليس مفاجئا، فنحن من دول العالم الثالث التي تطبق هذه المعايير لغايات إرضاء المؤسسات الدولية، والتغني بأن لديها من الضوابط الشكلية ما يكفي لإقناع هذه المؤسسات والدول المانحة، بأن التشريعات المطبقة تكفي لحماية المال العام.
عمليا، ما يتوفر من تشريعات، لا يعني أن ثمة رقابة حقيقية ومراجعات لكشوف حسابات أرصدة المسؤولين، فالالتزام بالتشريعات صوري لا أكثر.
ضعف المساءلة يرتبط بعوامل أخرى، تتعلق بعدم توفير المعلومات للمواطنين، ما يحد من الرقابة الشعبية على موظفي القطاع العام، ويوفر بيئة خصبة لإطلاق الاشاعات على المسؤولين، بسبب أجواء عدم الثقة السائدة، والتي تدعو للتشكيك بكل ما هو موجود.
اليوم، المطالبة بمزيد من تشريعات النزاهة في أَوْجها، وليس المهم أن تستجيب الحكومة بوضع التشريعات، بقدر تركيزها على التطبيق، الأمر الذي يتطلب وضع منظومة إجرائية لا يُقفَز عنها كما كان يحدث في الماضي، بحيث تضمن الالتزام بالقانون نصا وروحا.
فإذا كان من الصعب استرداد ما نُهِب من المال العام في الماضي، لأن الفاسدين كانوا في غاية الذكاء واستخدموا ما يتيحه القانون من منافذ لقوننة فسادهم، فإن من المهم الآن وضع كل التشريعات والتعليمات التي تمنع ذلك مستقبلا.
لن أتحدث عن شخصيات العيار الثقيل، وسأركز على الموظفين العاديين في وسط السلم الوظيفي في الدوائر الحكومية، ممن باتوا يسكنون الفلل ويمتلكون المزارع، بعد أن تساهلوا بحماية المال العام وسهّلوا الاعتداء عليه، في ظل تفشي ثقافة مجتمعية، تقبل بالفساد وممارساته، تبرره وتشرعنه، كل لأسبابه.
النظرة الجديدة للفساد، وعدم تجريمه مجتمعيا، جعلت التطاول على أموال الخزينة سهلا وبأشكال متعددة، تحقق كسبا ولو قليلا، يبدأ بحفنة دنانير، ولا أحد يعلم أين ينتهي.
قانون "من أين لك هذا؟" مطلب شعبي، بيد أن إقراره دون توفر الإرادة لتطبيقه لن يضيف شيئا لملف محاربة الفساد.
العبرة ليست في كثرة التشريعات بل الالتزام بها، وإحياء الإيمان بكل القيم الأخلاقية التي كانت تقف سدا منيعا في وجه الفساد، وإعادة الهيبة لدولة القانون والمؤسسات، التي لا تتوفر إلا في دولة ديمقراطية، تؤمن بضرورة توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.الغد