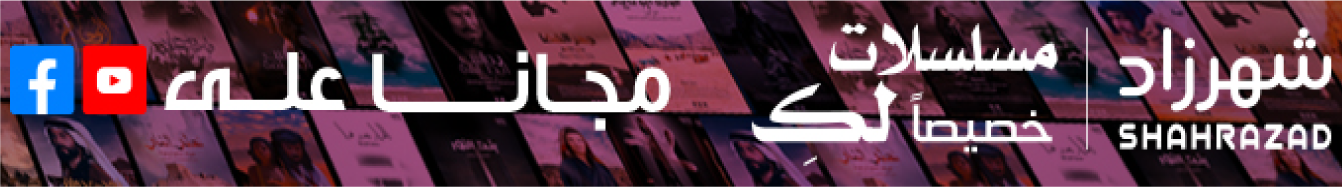بعد انفراط العقد

فعلا إنها معركة حاسمة تلك التي وقعت على أرض جامعة مؤتة، حيث استخدمت فيها كل الأسلحة البيضاء والميكانيكية والألعاب النارية، ووقعت إصابات، وكان هناك فرّ وكرّ حتى حسم الصراع لصالح من تآمروا على دولة المؤسسات، وتأكدت نظرية فشل المؤسسات في ضبط الأمن ومنع التجاوزات.
لن أعيد الكرة وأتحدث عن خطط تدمير الجامعات وإجهاض أهدافها الحقيقية، المتمثلة في تنشئة أجيال واعية ومسيسة، تكون قيادات المستقبل الذي بات كثيرون قلقين عليه.
ولن أجدد العتب على المؤسسات التي هدفت، منذ عقود، إلى إفراغ الجامعات من دورها التنموي التنويري، وسعت إلى السيطرة على مفاصل الحياة الجامعية، حتى أحكمت قبضتها إلى درجة خنقت معها التعليم والجامعات وإدارتها وهيئاتها التدريسية.
اليوم الكلام لن ينفع، وكل المطالب برفع القبضة الأمنية عن الجامعات، حتى تلك التي جاءت بعد فوات الأوان، لم يتم الالتزام بها، ما جعل الجامعات نماذج مصغرة عن المجتمع الكبير المنقسم على نفسه، تبعا للعشيرة والعائلة والجغرافيا والديمغرافيا، وولاءات أصغر من تلك بكثير.
اليوم، المشكلة لا تقتصر على الجامعات التي انتهكت حرماتها، وفقدت قيمتها؛ إذ كيف يستوي أن تضحي صروح العلم التي خرّجت قادة وعلماء عظماء، ساحات لمعارك تسيل فيها الدماء، وتغلق قاعات المحاضرات لتكون حصنا للمتقاتلين، وموقعا لتفجير الألعاب النارية؟
إعادة السيطرة على الأمور في الجامعات ووضعها في نصابها الطبيعي لا ينفصل عن فكرة محاولة سحب فتيل الأزمة التي تعصف بالبلد من كل الاتجاهات. فهي في بعض الأحيان أزمة بطالة، وفي أحيان أخرى غضبة جياع، وفي دوار ما اعتصام للأيتام.
الأزمة تشعبت إلى درجة تشتت التركيز والتفكير، وتضعف القدرة على التحليل وتقديم الحلول؛ إذ نصحو على اعتصام لانقطاع المياه، ونغفو على آخر احتجاجا على قرار رفع الأسعار.
وكل هذه الأزمات الفرعية محاطة بأزمة قارية واسعة، هي تلك المرتبطة بتراجع الحياة العامة، وتردي المشهد المحلي لدرجة فقدنا معها القدرة على تقدير قيمة الأشياء من أمن وأمان واستقرار.
وتشخيص المشكلة لمعرفة التحولات الخطيرة التي ألمت بالمجتمع ضرورة، وهي الأهم في هذه المرحلة.
والعودة أربعة عقود إلى الخلف ستمكننا من وضع الأسباب على الطاولة، إذ لا يستوي حل المشكلة بدون تشخيصها ومعرفة دواعيها.
ثمة عوامل كثيرة أوصلتنا إلى ما نحن عليه. بمراجعة سريعة، سنكتشف أن الجريمة التي ارتكبت بحق الحياة الحزبية أفرغت الحياة السياسية من مضمونها، وخلقت جيلا يعاني فراغا فكريا غير آبه بشيء ولا يعي هماً غير العنف، بعد أن تم تقسيم المجتمع إلى فرق متحاربة متضادة متناحرة، ليس على قضية أو فكرة، بل على أصول ومنابت، وعلى قاعدة "فرق تسد". الانتكاسة الديمقراطية التي بدأت منذ العام 1993 باعتماد الصوت الواحد، أدت ذات الهدف وقسمت العرب أعرابا، وأفقدت السلطة التشريعية خصالها الحقيقية، لتصبح أداة مسيطرا عليها بدلا من أن تكون سبيلا للسيطرة على باقي السلطات. وفقدنا بذلك أولى السلطات.
أُضعفت الحكومات في ظل تيار يسعى للسيطرة على كل شيء، وبدأنا نرى حكومات ضعيفة محكومة بقرار غيرها، وغير مستقلة، ولا تملك من أمر ولايتها العامة شيئا، وفقدنا بذلك السلطة التنفيذية.
وفي ظل غياب الأدوار الحقيقية للسلطات، صارت لدينا سلطة واحدة قادرة على الإمساك بزمام الأمور لتسخر الوطن بذلك لمصالحها وتوجهه حيث تريد. زاد الطين بلة شيوع ظاهرة الواسطة، الأمر الذي أفقدنا الإيمان بفكرة العدالة وتكافؤ الفرص التي تكسرت أمام المحسوبيات، ما أفرز شعورا بغياب العدالة، وجعل الفرص معتمدة على كل شيء إلا الأهلية والقدرة، حتى فقدت الثقة وضاع هدف العقد الاجتماعي القائم.
ومع انفراط العقد، اختلط كل شيء بالآخر، وعمت الفوضى، وصار أخذ الحق باليد بدون أدنى اعتبار للقانون ممكنا، حتى فقد كل شيء بريقه، وصارت الجامعات ساحات معارك، والمدارس والطرقات كذلك. مع كل هذا العنف، هل ما نزال آمنين على أنفسنا وأرواحنا وأبنائنا ومستقبلهم؟ أخشى أن الجواب لا، ومن الحق والعدل المطالبة بكل ما سلب واختطف منا.
(الغد)