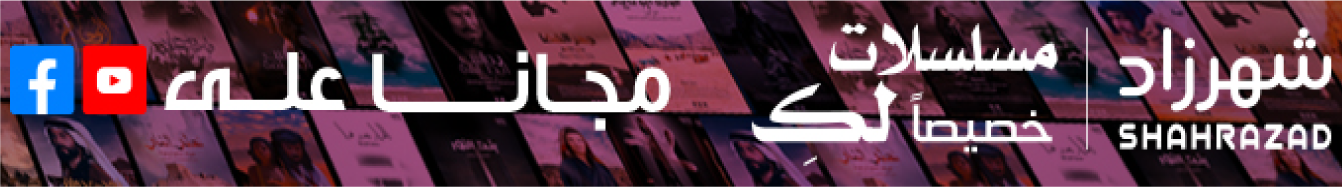مرتزقة السياسة والتسلط

خلال عام ونصف العام من عمر الربيع الأردني حتى الآن، أعطتني المحاضرات التي دُعيت لإلقائها على مساحة الوطن، شماله وجنوبه وشرقه وغربه، فرصة نادرة للالتقاء بنماذج من جميع شرائح هذا الشعب الطيب. وقد استحوذ على اهتمامي ما سمعته من أبناء وطننا العزيز، وما يشكله ما يقولون من جامع مشترك بينهم، يعكس ما لديهم من قلق وتخوفات حول المستقبل الذي كثرت وعود الإصلاح لتحقيقه، والخشية أن تكون امتداداً لواقع مرفوض طالت الشكوى منه، عن طريق إلباسه أثواباً براقة، مع إبقاء المضمون على حاله.
ومع أن محاضراتي ولقاءاتي بالناس خلال العشرين سنة الأخيرة لم تنقطع، إلا إني لاحظت أن صراحة الناس وجرأتهم في الطرح خلال فترة الربيع الأردني، قد تجاوزت حواجز الخوف الذي كان يسيطر على الجميع قبل تلك الفترة. ومما يسترعي الاهتمام، هذا الوعي الذي بدا على ألسنة المواطنين في التعامل مع واقعهم وتحليله، ومدى حبهم وحرصهم على وطنهم، وما يتطلعون إليه من إصلاحات حقيقية لا شكلية.
ففي جميع ما استمعت إليه، كانت محصلة الشكوى متماثلة، وهي: إدانة مرحلة مضت، بمن فيها من أشخاص ما يزالون يتناوبون على السلطة، رغم ثبوت أنهم غير راشدين بما أوصلونا إليه، وعدم الثقة بالوعود، وعدم القناعة بأن ما تم من إجراءات، وما يوصف بأنه إصلاحات، يمكن أن يحقق مستقبلاً أفضل من هذا الواقع الذي أصبح يرفضه الجميع.
لم يكن ما سمعته كلاماً مرسلاً، وإنما كان واضح المضمون والأسباب، مصحوباً بأمثلة من الواقع. وكان الجميع ينطلقون من حرص على ضرورة الإصلاح، وممارسة الضغط المجتمعي لتحقيقه، بأسلوب سلمي حضاري. وكانوا يتساءلون بمرارة، عن مفارقات بين ما يسمعون عن الإصلاح المصحوب بالدعايات الإعلامية الضخمة لتسويقه، وبين ما يرونه على الواقع من سوء وترد.
ومن أمثلة ما سمعت، أنه ليس هناك من مسؤول لا يعترف بوجود فساد، لكن الغريب أنه لم يتم العثور على فاسدين. ويتساءل الجميع: كم فاسدا من الكثيرين الذين أصبحوا محل إدانة شعبية، أُلقي القبض عليهم؟ وكم من مال الخزينة المنهوب عاد إليها؟ أقول إدانة شعبية، لأن من استمعت إليهم كانوا يتحدثون عن شخصيات دخلت الوظيفة العامة ولا تملك سوى راتبها، ومع ذلك ظهرت بين يديها الملايين، سواء أثناء الوظيفة أو بعد الخروج منها، في صورة قصور وأراض ومساهمات وشركات لهم وللأبناء، في حين أنك لو بعت كامل أراضي قرية الواحد منهم، لما كان ثمنها كافياً ليبني جزءاً من قصره! ووفقاً لما قاله البعض، فإن دول الخليج تُعيّرنا بأن ما تقدمه من مساعدات للشعب الأردني يستحوذ عليها الفاسدون، في حين نبّه آخرون، بأن أميركا ودول الخليج القادرة على الدفع، تشترط لتقديم المساعدات أن يفتح الأردن حدوده لقوى التدخل بالشأن السوري. ورغم التعذّر بأن الوضع الداخلي، وما يشهده الأردن من مسيرات، لا يسمح بذلك، فإن الضغط ما يزال مستمراً علينا للقبول كما تعودوا! ويضيف بعض ثالث، بأن الحكومات الفاسدة، وشلل الفاسدين الذين تولوا أمرنا، أوصلونا إلى وضع أصبح علينا فيه أن نستجدي.
وفي المحصلة، فإن من استمعت إليهم قانعون بأن دين المليارات على الأردن ذهب لجيوب حان وقت استعادته منها. فإن قلت لهم إن هناك جهات رسمية لمكافحة الفساد، ولجانا للتحقيق للوصول إلى الفاسدين، يأتيك الرد سريعاً بالقول: وهل ترك من قيل للشعب بأنه يمثلك في مجلس النواب، فاسداً دون أن يعطيه صك براءة ونزاهة؟! ثم أين هي دوائر الأمن والرقابة من ذلك، وهي التي تحصي على الناس أنفاسها، وتسجل كل حديث ومكالمة هاتفية، ولديها العيون في كل دائرة وظيفية، بل وفي كل شركة وبنك ومؤسسة وفندق، فلماذا لم تقدم ما لديها وعندها الكثير؟!
بل إن أساتذة الجامعات ممن تحدثوا، يخبرونك بمرارة أن أكثر ما يقلق هو هذا الانحدار في القيم والأخلاق الذي أدى إلى أن يستسهل أصحاب المراكز في الدولة التوسط لأبنائهم وغيرهم من طالبي الوساطة، ليس لتنجيح الطالب فقط، بل لإعطائه جيد جداً، رغم رسوبه.
وأكثر ما يلفت النظر، هو الأسئلة التي يوجهها حتى غير القانونيين، عندما يتندرون على قيمة مبدأ الشعب مصدر السلطة، ومبدأ الفصل بين السلطات، اللذين ينص عليهما الدستور، في ضوء واقع ملموس. ومن ذلك قولهم، إن الأردن في ظل قانون الصوت الواحد، تطلّب أن يكون لديه طواقم ذات معرفة وخبرة متراكمة في التزوير، وقد أنفق على هذه الطواقم وتدريبها الكثير، حتى أتقنت العمل وفق هذا التخصص، وأنتجت للأردن مجالس نواب متعاقبة، وضعت فيها الأغلبية المريحة لتشريع المطلوب، وتركت بعض المقاعد لمن يريدون المعارضة، لاستكمال الديكور الديمقراطي، فكان العرّاب أكثر ذكاءً من عرّاب حسني مبارك الذي زوّر الانتخابات لجميع أعضاء مجلس الشعب! ويتندّر السائلون بالقول: هل سيتم تجميد ممارسة هؤلاء لتخصصهم أو الاستغناء عنهم؟! ومن سيقنع بذلك، حتى لو أعلنت الحكومات عن قرار بهذا الشأن، ذلك أنهم يعملون خفية عن الأنظار، ولن تراهم عيون الذوات من أعضاء هيئة الإشراف؟! ويضيفون: إذا كانت الحكومة هي التي تعين النواب بالتزوير، وتعين الأعيان كمجلس تشريع، فهل يظل أي مكان للحديث عن مبدأ الشعب مصدر السلطة؟ ومع تعيين الحكومة لهؤلاء، ثم النص في الدستور على أن القضاة يعينون ويعزلون بقرارٍ موقع من رئيس الوزراء ووزير العدل وتوقيع الملك، فهل ظل هناك أي إمكانية لوجود مبدأ الفصل بين السلطات على أرض الواقع؟!
في أعقاب عشاء أقامه لي من دعوني لإلقاء محاضرة في إحدى القرى، جلس إلى جانبي أستاذ جامعي روى لي بأن أحد أبناء عمومته عندما تقاعد برتبة صغيرة من الجيش، قرر أن يترشح للنيابة في دائرتهم الانتخابية الصغيرة التي تقع ضمنها قريتهم. فباع قطعة أرض ورثها عن والده، لينفق ثمنها على حملته الانتخابية. وأضاف الأستاذ: إن عشيرتنا تتكون من عدة فروع، وكان لنا ديوانان، أحدهما لفرعين علاقتنا بهما ليست طيبة، ترشح عنهما حامل للدكتوراة، فقام المتقاعد بدعوة أبناء العشيرة على العشاء في ديواننا، ما عدا أبناء الفرعين طبعاً. وقبل أن ننتظم بحلقات حول المناسف، ألقى صاحبنا خطبة طلب فيها من الحاضرين الدعاية له في القرى المجاورة، باعتبار أن أصوات الحاضرين مضمونة له، كما طلب استثمار علاقاتهم مع أصدقائهم في تلك القرى. وذكر الرجل عدد الأصوات الانتخابية التي يمثلها الحاضرون، وأنه يكفي للفوز، أن يقوم كل واحد باستمالة اثنين أو ثلاثة من أصدقائه في الدائرة الانتخابية. ويضيف الأستاذ الجامعي، كان أغلب الحاضرين من حملة الشهادات والطلبة الجامعيين، وبعضهم من حملة الدكتوراه بتخصصات مختلفة، ويتوجب عليهم في مفهومه أن ينتخبوه ما دام ابن عشيرتهم. وصدّق الرجل أنه سيكون نائباً، إذ في لقاء جمعني به قال لي: أول ما أحصل على النمرة التي تُعطى للنواب، سأشتري سيارة الشبح، وسوف تنهش الغيرة أقاربنا، يقصد أبناء الفرعين! وزاد لكشف تفكيره الساذج بالقول: لن أسمح لأي واحد منهم أن يركب معي في الشبح! قلت للأستاذ: لماذا لم تنصحوه وتعيدوا إليه عقله؟ أجاب: سبق أن نصحه زوج أخته، أول ما عرف بالأمر، فخاصمه وقاطعه، حتى أنه لم يقم بدعوته إلى المناسف! واختتم محدثي روايته بالقول: لو ترشح في دائرتنا أعلم العلماء، فإن ابن عمي يعتبر أن علينا واجبا لانتخابه هو رغم جهله، فطبعاً لم ينجح، لا هو ولا المرشح الآخر الدكتور، مما زاد في تمزق عشيرتنا، ذلك أن فشل صاحبنا المتقاعد خلق عداوات مع من أصبح يشك في عدم انتخابهم له، واضطرنا هذا التفسخ الذي حدث إلى بناء ديوان ثالث يضم الفروع التي طالها الشك، مع الكثير من أقرب أقاربه، بمن فيهم أنا ووالدي وإخواني! مُضيفاً: إن العداوات بيننا تتزايد باستمرار، منذ ذلك الترشيح المشؤوم. ولو كانت الدائرة الانتخابية واسعة ومقاعدها أكثر، ويسمح فيها بتشكيل القوائم، لما كانت تقبله قائمة، ولما فكر بأن يرشح نفسه.
وفي قرية أخرى، قال لي صديق آخر: إن عشيرتنا تنتشر في عدة قرى. واتفق العقلاء على إجراء انتخابات داخلية، بحيث تقوم العشيرة بدعم من يحصل على أكثر الأصوات، واتفق الجميع على ذلك. وظهرت النتيجة، لكن واحدا ممن لم يحالفهم الفوز أعلن أنه سوف يرشح نفسه. وانقسمت العشيرة بين الاثنين. وعندما لم ينجح المرشحان، أصبح كل طرف يوجه الاتهامات للآخر، وما تزال العداوة بين الطرفين قائمة حتى الآن منذ سنوات!
وهنا أضيف، إن هذا الذي أسلفت، وغيره الكثير، تعلمه الأجهزة والسلطة بالتأكيد، لأن مهمات كتاب التقارير أو من يُفرغ أشرطة التسجيل، توصيل ذلك مباشرة، فهل رتبت السلطات التي تحكمنا أثراً على ما يجيش في صدور الناس؟! أليست وظيفة صاحب القرار هي أن يتلمس توجهات الشعب ليتجاوب معها؟! لست أدري كيف لا يتشكك الناس في مستقبل وطنهم، إذا كانت السلطة لا تسمع، حتى لصوت عشرات الآلاف التي تجأر بالشكوى، عبر المسيرات الصابرة سلمياً!
لقد بت أعتقد أن أصوات الناس، مهما كان علوها، لن تحرك ساكناً في وجدان السلطات وأجهزتها. واستمرار تفاقم الحال عند الشعب ينذر حقيقة بالخطر. وليس هناك من سبيل سوى ثورة بيضاء يقودها جلالة الملك انتصارا للشعب، من أجل التخلص من مرتزقة السياسة والتسلط على الناس.الغد