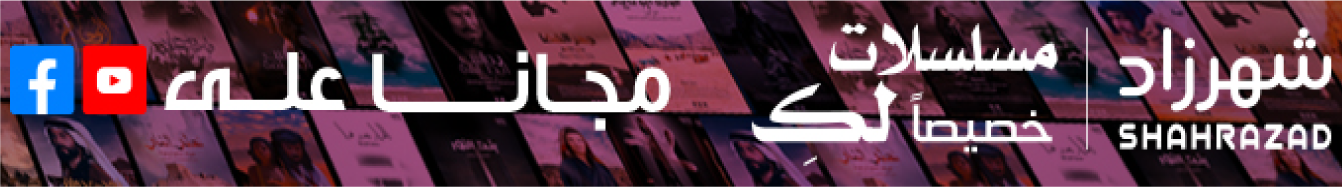قانون باسم أسامة دهيسات

لميس أندوني
جو 24 : ماذا نستطيع أن نقول لوالدة أسامة دهيسات التي اعتقدت أن ابنها في أمن وأمان في حرم جامعي يحمل أحلام المستقبل، وإذا به يحمل كابوس الموت لفلذة كبدها والحسرة الدائمة في روحها؟
اختفت ابتسامة أسامة المضيئة، ولنعترف أن العتمة سكنت زاوية في قلوبنا، حزناً على شبابه، وخوفاً على أنفسنا من أنفسنا، وقلقاً على استقرار وطن.
سواء توفي أسامة بسبب اختناق من الغاز المسيّل للدموع، أو نتيجة حالة طبية، فهو قضى نتيجة العنف العبثي الذي ضرب جامعة مؤتة، والذي هددنا ويتهددنا جميعاً، فلا يمكن المضي وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الأمور ستعود إلى نصابها، لأن الأمور لم تكن أصلاً في نصابها.
الدولة تتحمل عبء المسؤولية الأكبر والأساسي، أولاً لأنها انسحبت من دورها "كدولة"، وقلصت نفسها إلى مجرد مؤسسات نفعية، لفئات ضيقة وتضيق في وسعها، وإلى أجهزة سيطرة واحتواء تفرض الولاء والخنوع، وثانياً لسياساتها التي اعتمدت التفرقة وزرع الفرقة، ومنهجية تغليب المحسوبية على سيادة القانون ومفهوم العدالة الاجتماعية.
لا وجود لفكرة المواطنة أصلا في عقلية القائمين على صنع القرار، فالمواطنة تعني الوعي بالحقوق والواجبات، وبالتالي ظهور حركات سياسية واجتماعية، وهذا غير مقبول رسمياً، لذا كان ترسيخ العصبوية العشائرية والمناطقية، التي تُشوه الوعي السياسي والطبقي، فيتحول الشعور بالظلم إلى تناحرات غرائزية بدلاً من حراكات وأحزاب سياسية ذات رؤية تقدمية.
الأصل هو في عدم تخلي الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية لأن هذا الدور واجبها وحق للمواطن، ونتيجة عمله وكدحه ودفعه الضرائب، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون الشعب مصدر السلطات.
ما نشهده من انتشار وتفاقم للعنف المجتمعي هو نتيجة مباشرة لضعف واختفاء الدولة، ما دفع الأكثرية إلى الالتجاء إلى العشيرة، كملاذ حماية وضمان، فتسود حقوق، من خلال المحسوبية والوساطة والتبعية للمتنفذين، خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية، التي أفقدت معظم الناس الأمل في مستقبل آمن وتعليم جامعي بوابة لتحقيق الطموح والإبداع، وعلى الأقل الوعد بحياة كريمة.
سهولة اقتناء السلاح، وانتشاره، بشكل مريب، هو تجسيد لانسحاب الدولة، وتراجع احترام القانون، دليل على أن الفرد أصبح يرى أن من حقه أن يأخذه بيده،فتسود تدريجيا شريعة الغاب، وما نراه هو المقدمة لما قد يأتي.
لكن مأساة مؤتة تعكس أيضاً حجم التدخل الأمني في مؤسسات التعليم العالي بالأردن، ونتيجة لسياسة التدخل، بشكل سافر أحيانا بهدف منع النشاطات السياسية، في حين يتم تشجيع النزعات العصبوية العشائرية والجهوية، واستعداء الطلبة على بعضهم، باسم " الانتماء"، وبالتالي يتم غض النظر عن حمل السلاح و الاعتداءات، إذا أدت إلى تقويض الفكر المعارض، وإضعاف التنظيمات الطلابية.
عدم تطبيق العقوبات على الطلاب المتورطين في أعمال عنف، وتطويع القانون لوساطة أصحاب النفوذ، يقع في صلب المشكلة، لكن المسألة أعمق في جذورها؛ فالعقوبات لا تكفي، فحبس حرية العقول في الجامعات في وقت تتاح فيه حرية حمل السلاح والاعتداءات، هي نتيجة قرار سياسي منهجي، يرى الخطر في العقول الحرة ولا يراها في عقول مكبوتة ومشوهة، في قصر نظر خطير وفظيع.
تكريما لروح أسامة دهيسات، أقترح على المختصين كتابة قانون يحمل اسمه، ينظم شروط اقتناء السلاح وحمله، وحظره التام في المؤسسات التعليمية، فقد حان الوقت، وإن يكن لم يتأخر.
القانون لن يقدم حلاً لأزمة السياسة الاجتماعية، وجذورها لكنه سيكون خطوة لإنقاذ أرواح و مجتمع من بدايات تفكيك، فلا عزاء لنا إذا سمحنا بضياع الوطن، ولكن قد يغفر لنا أسامة إضاعتنا لشبابه وحياته، وإن كنت لا أدري اذا كنّا نستطيع المغفرة لأنفسنا.
اختفت ابتسامة أسامة المضيئة، ولنعترف أن العتمة سكنت زاوية في قلوبنا، حزناً على شبابه، وخوفاً على أنفسنا من أنفسنا، وقلقاً على استقرار وطن.
سواء توفي أسامة بسبب اختناق من الغاز المسيّل للدموع، أو نتيجة حالة طبية، فهو قضى نتيجة العنف العبثي الذي ضرب جامعة مؤتة، والذي هددنا ويتهددنا جميعاً، فلا يمكن المضي وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الأمور ستعود إلى نصابها، لأن الأمور لم تكن أصلاً في نصابها.
الدولة تتحمل عبء المسؤولية الأكبر والأساسي، أولاً لأنها انسحبت من دورها "كدولة"، وقلصت نفسها إلى مجرد مؤسسات نفعية، لفئات ضيقة وتضيق في وسعها، وإلى أجهزة سيطرة واحتواء تفرض الولاء والخنوع، وثانياً لسياساتها التي اعتمدت التفرقة وزرع الفرقة، ومنهجية تغليب المحسوبية على سيادة القانون ومفهوم العدالة الاجتماعية.
لا وجود لفكرة المواطنة أصلا في عقلية القائمين على صنع القرار، فالمواطنة تعني الوعي بالحقوق والواجبات، وبالتالي ظهور حركات سياسية واجتماعية، وهذا غير مقبول رسمياً، لذا كان ترسيخ العصبوية العشائرية والمناطقية، التي تُشوه الوعي السياسي والطبقي، فيتحول الشعور بالظلم إلى تناحرات غرائزية بدلاً من حراكات وأحزاب سياسية ذات رؤية تقدمية.
الأصل هو في عدم تخلي الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية لأن هذا الدور واجبها وحق للمواطن، ونتيجة عمله وكدحه ودفعه الضرائب، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون الشعب مصدر السلطات.
ما نشهده من انتشار وتفاقم للعنف المجتمعي هو نتيجة مباشرة لضعف واختفاء الدولة، ما دفع الأكثرية إلى الالتجاء إلى العشيرة، كملاذ حماية وضمان، فتسود حقوق، من خلال المحسوبية والوساطة والتبعية للمتنفذين، خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية، التي أفقدت معظم الناس الأمل في مستقبل آمن وتعليم جامعي بوابة لتحقيق الطموح والإبداع، وعلى الأقل الوعد بحياة كريمة.
سهولة اقتناء السلاح، وانتشاره، بشكل مريب، هو تجسيد لانسحاب الدولة، وتراجع احترام القانون، دليل على أن الفرد أصبح يرى أن من حقه أن يأخذه بيده،فتسود تدريجيا شريعة الغاب، وما نراه هو المقدمة لما قد يأتي.
لكن مأساة مؤتة تعكس أيضاً حجم التدخل الأمني في مؤسسات التعليم العالي بالأردن، ونتيجة لسياسة التدخل، بشكل سافر أحيانا بهدف منع النشاطات السياسية، في حين يتم تشجيع النزعات العصبوية العشائرية والجهوية، واستعداء الطلبة على بعضهم، باسم " الانتماء"، وبالتالي يتم غض النظر عن حمل السلاح و الاعتداءات، إذا أدت إلى تقويض الفكر المعارض، وإضعاف التنظيمات الطلابية.
عدم تطبيق العقوبات على الطلاب المتورطين في أعمال عنف، وتطويع القانون لوساطة أصحاب النفوذ، يقع في صلب المشكلة، لكن المسألة أعمق في جذورها؛ فالعقوبات لا تكفي، فحبس حرية العقول في الجامعات في وقت تتاح فيه حرية حمل السلاح والاعتداءات، هي نتيجة قرار سياسي منهجي، يرى الخطر في العقول الحرة ولا يراها في عقول مكبوتة ومشوهة، في قصر نظر خطير وفظيع.
تكريما لروح أسامة دهيسات، أقترح على المختصين كتابة قانون يحمل اسمه، ينظم شروط اقتناء السلاح وحمله، وحظره التام في المؤسسات التعليمية، فقد حان الوقت، وإن يكن لم يتأخر.
القانون لن يقدم حلاً لأزمة السياسة الاجتماعية، وجذورها لكنه سيكون خطوة لإنقاذ أرواح و مجتمع من بدايات تفكيك، فلا عزاء لنا إذا سمحنا بضياع الوطن، ولكن قد يغفر لنا أسامة إضاعتنا لشبابه وحياته، وإن كنت لا أدري اذا كنّا نستطيع المغفرة لأنفسنا.